
العروبة... مفهومٌ جغرافيٌّ ثقافيٌّ آراميٌّ
"لا تكن صريع الأشكالِ، أي كيف تقال الأشياء. همُّكَ أن تكونَ في الحقيقة، وهي تدلك على الثوب الذي يليق بها" (المطران جورج خضر)
مقالٌ بعنوان «اللغة الآرامية في مواجهة الاعتداءات والنسيان»، منشورٌ في مجلَّةٍ «فينيق» الإلكترونية، أثارَ انتباهي، فضلاً عن مقالات أخرى سيأتي ذكرها نُشِرَت في الأسابيع الأخيرة. لستُ من الذين لا يحترمون عواطفَ الناسِ، ولكلِّ إنسانٍ عاطفتُهُ، إلّا أنَّني أقفُ إجلالاً أمام العواطفِ المُروَّضةِ بالمعرفة، فهي التي تُبعِدُ الإنسان عن التحَيُّز والتطرُّفِ والعنف، سواءٌ أكان ذلك كلاماً أم فعلاً. وقد حَسَمَ هذا الأمر الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، حين قال: «ما جادلتُ جاهلاً إلّا وغلَّبني وما جادلتُ عاقلاً إلّا وغلبته». والاستشهاد بقولِ الإمام ليس موجهاً ضدَّ أي شخص، ولكنّي أورده كمسلَّمة وكحقيقة كونية. وقد جزم بهذه الحقيقة زعيمنا الراحل أنطون سعاده منذ تسعين سنة حين قال: «المجتمع معرفة والمعرفة قوة». اعتداءاتٌ ونسيانٌ مِنْ مَنْ؟
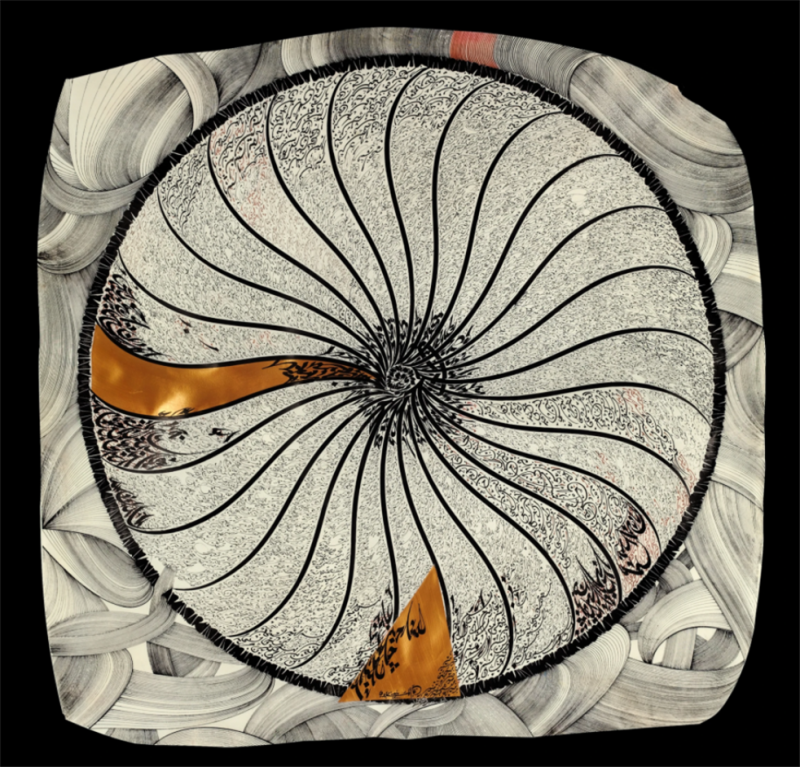
ذلك المقال مثالٌ لمحاولات الانعزال العديدة، التي تهُبُّ رياحُها في أرجاء الهلال الخصيب، رافعةً شعار «التمايز» عن المجتمع الواحد، تارة باختلاف اللغة وأخرى بربطها بديانةٍ ما كسباً لأفضليتها على الديانات الأخرى. وأفضلية دينٍ على دين ابتكارٌ موسويٌّ. فاللغة استُحدِثَتْ كوسيلةٍ للتواصل، وارتبطت بالطبيعة، فأكسبتها جمالية في حروفها وكلماتها. والارتباط بالطبيعة طَبَعَ حياة الإنسان في الهلال الخصيب على مدى عشرات القرون؛ فقد بدأت صوتيَّة-تصويرِيَّة، وتطوَّرت إلى المسماريَّة، ثمّ إلى الأبجديَّةَ. وقد سَرَّني أن أسمَعَ لُغَوِيّاً (قد يكونُ جزائِريّاً) يصِفُ أبجديّتَها بالسماويَّة والأرضية والطاقَوِية (عناصر الكون): فالميم تدخلُ في السماء والقمر والنجم والملائكة، والراءُ أرضيَّة بدخولها في «قبرٌ» و«ترابٌ» و«بحرٌ» و«صخرٌ» و«رملٌ» و«بشرٌ»، والحاء طاقويَّة بإشارتها إلى الحرارة والحبِّ والحياة والحريقِ وبتنبيه الطفل من الحرارة بقولِهم «أحٌّ».
محاولات «التمايز» لم تنحصر بالسريان، وهم الآن عدة طوائف منذ مؤتمر «خلقيدونيا» عام 451 م.، حين انفصلوا عن كنيسة روما (وروما اسمٌ آراميٌّ معناهُ العلوّ، إذ إنها بُنِيَتْ على تلالِ عالية). إنما الأمر تَعَدّى إلى المكونات المجتمعيَّة الأخرى من طوائف، كالآشوريين-السريان والموارنة والأكراد والأرمن وبعض الإسلاميين السلفيين الذين ربطوا اللغة العربية بالتراث الإسلامي. فمن يكونُ عربياً ومن لا يكون؟ والعربية في القرآن كلام الله خاطب بها الشعبَ الذي يفهمها وأنطقهُ بها. وفي حديثنا عنها وعن أصلها لا بد من التطرُّقِ إلى المقالات الأخرى، في آخر ما نُشِر في الصحافة عن الواقع الحالي، ثمَّ الاستعانة بالتاريخ لكي يتوضَّحَ مفهوم العروبة، ولكي نتعرَّفَ إلى أصولِ لُغَتِنا.
وما دمنا في حديثٍ عن السريان، لا بدّ من السؤال هل هؤلاء أمَّة مستقلة عن المجتمع الحالي؟
نعم، الأشوريون السريان شُرِّدوا من سهل نينوى وماردين وديار بكر وطور عابدين شمال إقليم الجزيرة، باتجاه الجنوب -وسنتطرّق إلى أسباب الهجرة- ولكنهم لم ينفصلوا يوماً عن وطنهم الأمّ الذي حضنهم حيثُ أعادوا تأسيس مدنٍ كالدرباسية وعامودا والقامشلي والحسكة، وأنشأوا مزارع خضراء على ضفاف نهر الخابور، حَوَتْ جميع أنواع الحبوب والأقطان والخُضر والفواكه. وبفضلهم أصبحت منطقة الجزيرة مخزناً للمواد الغذائية والمعيشية في الشام. وبفضل الجزيرة سُمِّيَت الشام «كاليفورنيا» أو «أوكرانيا» الشرق. فالسريان، بكلِّ طوائفهم، من موارنة وآشوريين وكاثوليك هم مُكَوِّنٌ وطنيٌّ منتشرٌ في أنحاء الهلال الخصيب. وكم تمنَّيتُ على أولياء الأمر في الشام إعادةَ إحياء اسم الجزيرة، بجغرافيته الأصلية، بدلاً من الاسم الحالي.
وفي هذا المضمار يُطِلُّ مقالٌ مهمّ لرفيقنا سركيس أبو زيد في «الأخبار»، بتاريخ 17 تشرين الثاني 2022، تحت عنوان «المسيحية المشرقية: تحدِّيات المعنى والدور»، رَكَّزَ فيه على الواقع الحالي. يقول: «إنَّ ارتباك المواقف السياسية المسيحية (أغلبُ أصحابها سريان مشرقيون)، اليوم، ناتجٌ تاريخياً من أنَّ المسيحيين بشكلٍ عام يتجاذبهم تيّاران أساسيان:
تيَّارٌ أول، مشدودٌ باتجاه الغرب وثقافته ومشاريعه...» و«تيّارٌ ثانٍ متمسك بجذوره المشرقية الأنطاكية العروبية...». هذا صحيح وأهنِّئهُ على ربطه المشرق والعروبة سوياً وكأنهما واحد.
التيار الأوّل، وهو الأصغر والأقلُّ عدداً، مثَّلته الطوائف الكاثوليكية وفي طليعتهم الموارنة (السريان)، رغم التناقض الحاصل حالياً بين الموقف السياسي للبطريركية المارونية بـ«التمايز»، وبين موقف الفاتيكان الحالي الداعي إلى تعايش الأديان في المنطقة. فموقف البطريركية المارونية في المنطقة سببه ما وصفه الأستاذ سركيس أبو زيد قائلاً: «دينامية الطوائف الإسلامية لجهة تزايد العدد وانتشار العلم وازدياد الثروة والنفوذ...» ومن الجهة المقابلة «الخوف على الكيان... والرعب من إرهاب تكفيري إرهابي...».
انتشار العلم يجب ألّا يكون سبيلاً للخوف. فالمعرفة هي، في الحقيقة، شيءٌ إيجابيٌ كفيلٌ بوضع الثروة والنفوذ في خدمة الخير العام للمجتمع، أي «توزيع الثروة على أساس الإنتاج» كما دعا إليه أنطون سعاده، والنفوذُ هو لدولة المجتمع الموحد، وليس لسلطة ملوك الطوائف كما هو الآن. والخوف على الكيان، وهو كيانٌ سياسي، يجب أن لا يؤدي إلى الانعزال برفع شعار «التمايز» في اللغة والثقافة. في كتابه «تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار» يقول الأب هنري لامنس اليسوعي إن الموارنة ليسوا سلالة نقية. فهم خليط شعوب أو زُمَرٍ آرامية لم يستطع العنصر اليوناني هَيْلَنتَها... وهم أتوا إلى لبنان إمّا من بلاد الأرمن التي كانت تشمل كل الشرق التركي الآن، أو من جبال اللُّكام (إنطاكية)، أو من أفاميا. صحيح أن الكيان اللبناني يتمايز بثقافة الحرية والإبداع والتمسك بالمؤسسات رغم أنها في عُهْدَةِ الفاسدين، ولكنَّ هذا التمايز هو لدور رسالي قيادي في المنطقة وليس للانفصال، خصوصاً بوجود تقارب لهذه الثقافة من مثيلتها في سائر دول الهلال الخصيب، كالعراق والشام والأردن بضفَّتيه. وعصر بيروت الذهبي 1950-1975 خير دليلٍ على ذلك؛ فقد أسهم فيه مبدعون ليسوا من الكيان اللبناني فقط، بل من كيانات الشام والعراق وفلسطين والأردن. كما أن لبنان له الفضل الكبير في حفظ اللغة العربية أمام محاولات التتريك. ففي تلك الفترة كان للبنانيين وللشوام فضلٌ كبير في دعم الثقافة العربية في مصر بوثبتها الحضارية وبكل المكوّنات الصحافية والأدبية والفنية والمسرحية. ولم يعان الموارنة من المسلمين العرب ما عانوه من اليعاقبة المسيحيين السريان. وتحدي الإسلام التكفيري، كما يقولُ الأستاذ أبو زيد، «لا يواجهُ المسيحيين المشرقيين فقط، بل هو تحدٍّ مصيري للإسلام المعتدل أو الليبرالي، كما هو تحدٍّ للعروبة نفسها...». وسنرى ما أصل العروبة الحقيقية.
وأيضاً لا بد من التنويه بمقال الدكتورة صفية أنطون سعادة تحت عنوان «المواطنة بين المسيحية المشرقية والعروبة الإسلامية» («الأخبار»، 24 تشرين الثاني 2022).
المشرق في «المسيحية المشرقية» والعروبة في «العروبة الإسلامية» رُبِطا بالدين، وكأنَّ الشمس لم تشرق في المشرقِ إلّا على المسيحيين، وكأنَّ العروبة لم تظهر إلّا للمسلمين، وفي الإسلام أممٌ غير عربية. والمفهومان ارتبطا بالأرض والثقافة في مسيرتهما الحضارية، وكانا واحداً. الذي ربط المشرقية بالدين المسيحي هو الغرب نفسه، كما اخترَعَ تسميات أخرى كـ«الشرق الأوسط» و«الشرق الأدنى» و«شرقيِّ المتوسط» و«الشرق العربي». «مرتا، مرتا، إنَّكِ تهتمين بأمورٍ كثيرة وتَضْطَرِبين! إنما المطلوب واحدٌ»: الهلال الخصيب. هكذا أرادوا إعادة تسمية البلاد لتعمية العالم وتوجيه انتباهه بعيداً عن الحضارات التي قامت على هذه الأرض وامتازت بثقافتِها وتجاربها الروحية. والذين ربطوا العروبة بالدين وقعوا في الفخ الذي جعَلَ من الدين اليهودي قوميَّة.
وعن ارتباط اللغة بالدين وارتباطها بالدولة، تقولُ الدكتورة صفيَّة سعادة: «أساس الدين إنقاذ الإنسان الفرد... بينما الهوية الوطنية/القومية تختصّ بوطنٍ ومجتمعٍ محدَّدين»، و«الشخص الوطني/القومي لا يشعرُ بتَمَيُّزِهِ عن الآخرين...»، وهو «لا ينفصمُ عن مجتَمَعِه وأرضِهِ... الأرض هي المرجعية التي تحدد هوية الشخص... تعريف الشخص أصبح ملتصقاً بهويته الجغرافية، لا دينه وإثنيَّتهِ...». وخلصت الدكتورة سعادة إلى أنَّ «الاختلاف الإثني الوحيد الموجود والرافض للاندماج هم الكرد»، كما سنرى، وجزمت بأنْ «لا تمايز بين المسيحيين والمسلمين، فثقافتهم واحدة وكذلك لغتهم وجذورهم الإثنية مختلطة... وعلينا التخلّي عن إلباس هويتنا بلبوس ديني وإثني...». فنحن تَشارَكْنا في أرض «عشنا فيها (أو عليها) منذ القدم، وهي سببُ وجودنا، ومصيرُنا فيها واحد لا فرق بين عرقٍ وآخر أو بين دينٍ وملَّة وطائفة. فالمستعمرُ يحتلُّ الجغرافيا، ولا يحتَلُّ ديناً أو إثنيَّة».
وفي منشورٍ آخر تحدَّثَت عن فيلم «ميل جيبسون» عن المسيح واللغة الآراميّة التي بَشَّرَ بها. وللحقيقة الاسم «مسيحٌ» يقابله (مشيحا) في الآشورية-الآرامية، التي أنا مُلِمٌّ بها وتحدَّث بها أجدادي. الجذرُ واحد، إنّما تشكيلُ الحرف الأوّل في الجذر العربي الفصيح (العدنانية) وتنوين الحرف الأخير منه يقابلُهُ في الآراميَّة تسكين الحرف الأوَّل وانتهاء الاسم بالألف الطويلة بدلاً من التنوين. وهذا مُتَّبَعٌ في آلاف الأسماء، ومنها، كمثال، فُصحٌ/پصحا (ثلاث نقاطٍ تحت الباء)، قِيامةٌ/قْيامتا، نهرٌ/نهرا، عينٌ/عينا، دُبٌّ/دِبّا، جاموسٌ/جاموشا، جَمَلٌ/جُملا، جَدْيٌ/چِديا (جيم بثلاث نقط)، بَقٌّ (بعوض)/بَقّا... إلخ.
والكرد الذين ذكرتهم الدكتورة صفيَّة، هل هم شعبٌ ذو قومية؟ ومن كان وراءَهُمْ؟ فدورُهُم في التاريخ لا يُنسى. وقد قيل إنَّ «الذينَ لا يمكنهم تذَكُّرُ الماضي واستيعابُه... مقضيٌّ عليهم بتكراره بكلِّ أخطائِهِ ومآسيهِ». ويومنا هذا خيرُ شاهدٍ.
تاريخياً لم تكن حدودُ فارس أو إيران الكبرى تنحصر في حدود إيران الحالية، وإنّما شملت الشعوب التي عاشت بين أواسط آسيا وشرق جبال زاغروس شاملة هضبة إيران الحالية وبعض هضبة الأناضول. والكرد كلمة أطلقها الفرس على البدو والقبائل المتنقّلة من شعبهم.
فالأكراد هم من أصلٍ آريّ ومن الفرع الذي يسمى الهندو-أوروبي، وهم شعبٌ من الشعوب الإيرانية، وما الأسماء المتداولة (كردستان، أفغانستان، باكستان وتركمانستان) سوى أسماء مكوِّنات إدارية ضمن فارس الكبرى. ومن ثمَّ فهم ينتمون إلى القومية الفارسية. و«لغتهم» هي إحدى اللهجات الفارسية. وفي المخطوطات الإسلامية أيضاً ورد ذكر الكرد كعشيرة بدوية فارسية. يقول المؤرخ أحمد بن يحيى بن فضل الله العُمَري الذي وُلِدَ عام 1301 وعاش في القرن الرابع عشر، يقولُ في تحديده مكان انتشار الكرد: «الخطّ الفاصل العام بين العرب والأكراد... هي الجبال الحاجزة بين ديار العرب وديار العجم، وابتداؤُها جبال همدان وشهرزور، وانتهاؤُها بصياصي الكفرة، بلاد التكفور وهي مملكة سيس، وما هو مضاف إليها بأيدي بيت لارن:
فهمدان هي في إيران. وشهرزور منطقة إيرانية تقع شرق كركوك. وصياصي (حصون) الكفرة ومملكة سيس تقعان في المنطقة الشرقية من الأناضول.
قبل القرن السادس عشر لم يكن هناك كرديٌّ لا في العراق ولا في الشام. إلا أن الذي أدخلهم إلى المنطقة هم الأتراك أنفسهم، أو بالأحرى أجداد الأتراك، وهم العثمانيون. فقد استغلَّ العثمانيون ولاء الأكراد السني لمحاربة أبناء قومهم الفرس من الصفويين الشيعة. وبسبب ذلك منح العثمانيون رؤساء العشائر الكردية إقطاعات كبيرة حتى تحولوا إلى أمراء.
هذه العشائر استُخْدِمَتْ في الحرب ضد الصفويين، وبالتالي ضدَّ العرب. وحين انتصر العثمانيون على الصفويين الشيعة عام 1514، شجّعوا الأكراد على الامتداد جنوباً في سفوح جبال هكّاري وسفوح جبال طوروس من مدن الرها - جبال هَكَّاري، أي حيث كان يسكنُ المواطنونَ الباقون من الدولة الآشورية ومملكة الرها من السريان والأرمن.
لقد استخدم السلطان سليم العشائر الكردية كحاجز بشريّ ضد الدولة الفارسية الصفوية، وضد العرب أيضاً. فعلاقة السلطنة مع العرب لم تكن على ما يرام، والأستاذ سامي مروان مبيض يوردُ في كتابه «نكبة نصارى الشام» كيف ثارت ولاية دمشق ضد السلطان عام 1831، وقتلت واليه، وأعلن أهلوها قيامة إدارةٍ ذاتية. والثورة مهَّدت لدخول إبراهيم محمد علي باشا إلى الشام. هذه العلاقة المتوترة، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي أعطى بعض النفوذ لبريطانيا، أدّى، وبمساهمة السلطنة، إلى الفتنة الدينية التي قام بها الغلمان والعوام عام 1860 رغم جهود العقلاء لمنعها، ومنهم الأمير عبد القادر الجزائري وغيره من الوجهاء (ص: 18-35).
السلطان عبد الحميد قام بتشكيل فرق عسكرية شبه نظامية تحت إمرة الآغوات الأكراد سُمِّيت «الفرسان الحميدية»، وقام أيضاً بتسليمهم المناصب الرفيعة في الجيش العثماني، وأمور الدولة في البلدان العربية الواقعة تحت الاحتلال العثماني وخاصة الشام، إلى أن انتهت كل هذه الأراضي بين أيديهم وبمساعدة الدولة العثمانية. ولم تستطع الدولة العثمانية من التوسع شرقاً باتجاه العالم العربي إلا بعد أن عقدت تحالفاً مع الإمارات الكردية، وخاصة مع إمارة سوران بقيادة الكردي محمد باشا الراوندوزي (ميرا كورا) عام 1813 (ميرا كورا: كلمتان آراميتان معناهما الأمير الأعور)، وكان عصره دموياً مرعباً وأياديه تلطَّخت بدماء شعبنا. لقد كان يطمح إلى توسيع حدود إمارته صوب منطقة الجزيرة (تُلفَظُ بالآرامية-الآشورية «چيزَرْتا»، بالجيم المصرية، أي ثلاث نقاط تحت الجيم) التي يسكنها السريان والآشوريون واليزيديون والعشائرُ العربية من ربيعة في سهل نينوى (الموصل)، و بكرٍ ديار بكرِ، وتغلب الحلبيَّة الحمدانيَّة، وعشائر الشمَّر والجبور والعقيدات في سهول الجزيرة. أي إن أهدافه الحقيقية، حين انشغل العثمانيون في حروبهم المستمرة مع الروس واليونان والمصريين في عهد محمد علي، كانت قائمة على تأسيس دولة كردية في مناطق راوندوز، وألقوش، والموصل وأربيل والشيخان وسهل نينوى وسفوح هَكّاري وسنجار التي سكنها اليزيديون والآشوريون والسريان.
والقائد الكردي بدرخان بيك عام 1843، وهو زعيم إمارة بوتان، لم يكن ليختلف في مجازره عن ميرا كورا في إبادة الأرمن والآشوريين في مناطق سهل نينوى وأربيل وزاخو وهكارى، ودهوك.
فقليلٌ من الأكراد اندمج في المجتمع، وكان منهم في الشام وفي العراق رؤساءُ للجمهورية، ووزراء، ورؤساء للوزارة، ولكن الأغلبية، خصوصاً الذين عملوا مرتزقة عند الإنكليز وعند العثمانيين والآن عند الأميركيين، جُنِّدَت لمحاربة مكونات شعبنا من عرب وأرمن وآشوريين-سريان في المذابح التي ارتكبوها. والمذابح لم يقم بها الإسلام العربي، بل الإسلام غير العربي مدفوعاً بـ«الدودة الرومانية» كما وصفها الكاتب اليساري العراقي الراحل هادي العلوي، «التي لا تطيقُ منافساً لها أو متمرِّداً عليها... كما فعلت بقرطاجة حنّابعل، وتدمر زنوبيا، وحرب بوش الابن على العراق».
والحقيقة أنَّ التمايز الإثني لم يقتصر على الكرد فقط، بل شَمَلَ اليهود العرب. ومع أنّ المقال الذي نُشِرَ، حديثاً، للكاتبة المصرية زيزي شوشة في «رصيف» تحت عنوان: «هل طرد عبد الناصر اليهود من مصر» (وما تضمّنه المقال من آراءٍ للدكتور جوزيف مسعد والدكتور محمد أبو الغار) لا علاقة له بالمسيحية المشرقية، إلّا أنَّه يعالج دور الصهيونية في هجرة اليهود من مصر، والذي ينطبقُ على دورها في هجرتهم من الهلال الخصيب. فـ«بحسرةٍ يستعيدُ المصريون الليبراليون الحالة الكوزموبوليتانية المصرية التي شهدتها مدينتا الإسكندرية والقاهرة منذ بداية الأربعينيات وانتهت بحسبِ زعمِهِم بهجرة الجاليات الأجنبية وطرد اليهود من مصر...»، وبعد عرض تاريخي يُفَنِّدُ الدكتور جوزيف مسعد، أستاذُ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا-نيويورك، ويصلُ إلى الجزم بأنَّ «مسألة طرد اليهود من مصر هي لا تتعدّى كونها بدعةً صهيونية يسَوِّقُ لها بعضُ المصريين الليبراليين...». أمّا محمد أبو الغار، فيرى أنَّ إنشاء دولة إسرائيل كان سبباً رئيسياً في هجرة اليهود من مصر. والأمر نفسُه ينطبقُ على اليهود العرب في الهلال الخصيب. فالأهداف السياسية للحركة الصهيونية أصبحت معروفة، وقد وَقَعَ اليهود العرب في فخِّها، فكانت هجرتهم من الوطن الذي وُلِدوا فيه، وإدارة ظهورهم إليه، لا بل معاداته. «فالتمايز» عند اليهود العرب لم يرتبط بالدين فقط، بل ارتبط سياسياً بالحركة الصهيونية ومن ورائها «الدودة الرومانية».
أمّا الأرمن فقد ظلّوا بعيدين عن هذا التوجُّه العدائي ضدَّ شعبنا. إنّ ما فعله اليهود والأكراد بشعبنا لم يفعله الأرمن؛ فهم ينتمون إلى أمّة ظلَّت مستقلَّة، محافظة على الروح المشرقية، وكانت، خلالَ تاريخها، حليفة للمجتمع الخصيبي في كل العصور، وأسهمت في كثيرٍ من المشاريع الإنمائية، كشبكة القنوات المائية في الدولة الأشورية. تَعَرَّضت هذه الأمَّة، كمكونات أمّتنا، إلى المطامع والأحابيل الأجنبية الباحثة عن المرتزقة في خططها للسيطرة على مقدرات المنطقة، فبثَّت شعار «فرِّق تسدْ» مستعملةً التعصب الديني، فكانت المذابحُ والتشريدُ، ففقد الناس أحباباً وأقاربَ لهم، كما فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم. أمّا اللاجئون منهم إلى دويلات الهلال الخصيب القريبة هرباً من المذابح فحضنتهم أمَّتُنا، وانغمسوا في المجتمع، فكانوا مواطنين صالحين موالين له، وأخلصوا له بكلِّ شفافية.
والسؤال الذي ننتظرُ الآن جواباً عنه هو: من هم العرب؟ وما هي لغتهم؟
المؤرخ اللغوي محمد بهجت القُبَيْسي له كتاب بعنوان «حضارةٌ واحدة أم حضارات» بحث فيه عن أصل العروبة من حيث إنها حقيقة تاريخية لا علاقة لها بالدين، وإنّما هي ارتبطت بالأرض. «كلمة «عرب» موجودةٌ لدينا في الألف الثالث قبل الميلاد» (ص 30)، «والأكادية والإبلائية عرفت التمويم بدل التنوين» (ص 93)، وبدل الألف الطويلة في آخر جذر الاسم، والأمثلة كثيرة، كـ«بيتوم/بيتٌ/بيتا، زرعوم/زرعٌ/زرعا، قصروم/قصرٌ/قصرا، شرشوم/شرشٌ/شرشا»، وهكذا إلى آلاف الكلمات وجذرها بما أعرفه، شخصياً، باللهجة الآشوريَّة-الآراميَّة. ويقولُ في الصفحة (25): «لقد كَتَبَ ورقة بن نوفل العربية الفصحى بالخطِّ الآرامي المُرَبَّع وما عُرِفَ ذلك بالخط العبري، وقبل الإسلام كتبَ بنو ربيعة في شمال العراق (سهل نينوى) العربيَّةَ الفصحى بالخطِّ السطرنجيلي السرياني وسُمِّيَ بـ(الكرشوني) نسبةً إلى قريش...»، وقريش قبيلةٌ شاميَّة «أتَتْ من الشمال ولم تأتِ من الجنوب» (ص 56). واستهلَّ كتابَهُ بالجزم (ص 19): «إنَّ اختلاف نَمَط الخطِّ لا يدُلُّ على اختلافِ اللغة، وإنَّ وحدة نمط الخطِّ لا تدلُّ على وحدة (وحدانية) اللغة». ويتابع في الصفحة 103 من كتابه فيقول: «ومن الهامّ جداً أن نشير إلى أنّ كلمة «عربي» ظهرت إلى الاستعمال حين دَخَلَ الغازي الأجنبي إلى جغرافيتهم، فنجدُ أنَّ الآراميين مَيَّزوا أنفسهم وسَمّوا أنفسهم عرباً. فهذه المملكة العربية الآرامية شمال بغداد تُسَمّي نفسها [عربايا] وتعني بالآرامية العرب، أي أنَّ الآراميين سَمّوا أنفسهم عرباً». وكلمة عرب ارتبطت بالخصب وزخمه، والخصب شغلَ اهتمام كلِّ الحضارات التي ظهرت في منطقة الهلال الخصيب. والزواجُ المقدَّسُ منذ آلاف السنين كان مفهوماً إخصابيّاً، لا جنسيّاً. فالزواجُ بين الأرضِ والسماء نتجَت عنه الطاقةُ-الحياة. والخصب مصدره ثلاثة مكوِّناتٍ: الأرض، والماءُ، والطبيعة بدورة فصولها وهوائها. الماء، سواء كان الماءُ مطراً أو أنهراً. والكتاب (القرآن= قريانا بالآراميَّة)، في سورة الأنبياء شاهد بالوحي الإلهي: «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ»، صدقَ اللهُ العظيم. من الماء والأرض والطبيعة المحيطة بهما ظهرَ كلُّ شيءٍ حيٍّ.
ويمضي المؤرخ القبيسي في كتابه المذكور (ص 30) فيقول إنَّهُ في اللهجة العدنانية (العربية الفصحى) يقالُ: عربة إسماعيل (بئر زمزم)، وبئرٍ عروب (كثير الماء)، ووادي عربة (وادي الماء)، امرأةٌ عروب (كالماء الصافي)، العربات في دجلة (الطافية على الماء)، وفي الآرامية: أنا رب بيت عربة (أنا مدير دائرة المياه)، العراب في الكنيسة (يُعمِّدُ بالماء)، التعريب (الفصل بالماء للقمح والبرغل والرز). وفي الأوغاريتية: واكب عربة (راكب غيمة ماء). وفي الأكادية: عربتو (جوٌّ غائم).
هذه الكلمات وُجِدَت أكثر من ألفي سنة قبل «جنديبو العربي».
وكان للآراميين العرب ثلاثُ دُولٍ ذات استقلالٍ إداري لا سياسي هي: مملكة «ميسان» من جنوبيِّ بغداد الحالية إلى ضفاف الخليج الشرقية والغربية، مملكة «حد زاب» بين الزابين الأعلى والأسفل ومملكة «عربايا» وتعني الأرض الكثيرة المياه، أي الجزيرة التي اشتهرت بأنهارها الغزيرة. ونعرف أنَّ كلمة «عَرَبايا» آرامية بوجود ألف التعريف في آخرها كبقية الأسامي كصحنايا وسرغايا...إلخ، هذا الوجود الآرامي الذي سَمّى نفسه «عربايا» هو امتدادٌ يرجعُ عميقاً إلى بابل بفرعيها الأكادي والآشوري، لا بل، ورُبَّما، من خلال سومر إلى حضارة «العُبَيْد» وعاصمتها «أريدو» حيث بدأت اللغة التصويرية منذ سبعة آلاف سنة، وتطورت في المسمارية وأخيراً في الأبجدية.
يخلصُ الأستاذ القُبيسي، بناءً على أبحاثه اللغوية في آخر كتابه (ص 151)، إلى القول إنَّ: اللهجة الإبلائية، والأكادية (بفرعيها البابلي والآشوري)، والكنعانية/الأوغاريتية، والعمورية والأمازيغية، والآراميَّة، والنبطية، والصفائية، والتمودية، واللحيانية، والعدنانية (العربية الفصحى)، والسبئية-القحطانية، ولهجة معلولا، هذه اللهجات كلُّها أصلها اللغة العربية الأم، وقد تكونُ الأمُّ حضارة «العُبَيْد» التي قامت في العراق.
* كاتب وطبيب
التاريخ: 2022-12-22
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro










