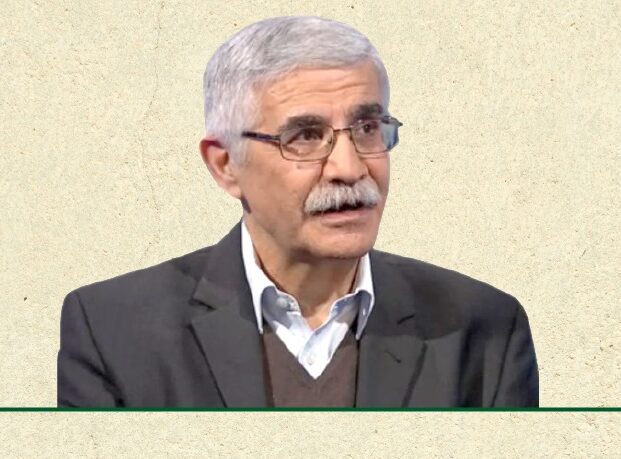
مفهوم الفداء عند سعاده: الجذور والأبعاد
التضحية ميزة اجتماعية راقية، تنتج عن نمو الوعي القومي ونشوء الوجدان الجمعي. وهي ترتبط عضوياً بإدراك الفرد أنه يقدّم شيئاً أو يتخلى عن شيء، مهما كانت قيمة هذا الشيء، من أجل الخير العام الذي يعود نفعه العميم على جميع أفراد المتحد.
والتضحية قرار ذاتي قد يتخذه شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، ومع ذلك تبقى هذه الخطوة عائدة لكل فرد. إن تناسي المنافع الشخصية لكي تتحقق المنفعة العامة يمثل ذروة الانتصار على النزعات الفردية. وغالباً ما تتراكم التجارب الإنسانية لتصبح مكوناً أساسياً من مكونات نفسية الجماعة وروحيتها ومعتقداتها الحضارية.
وإذا كان المجتمع هو أعلى مراتب العمران البشري، والإنسان قيمة فاعلة فيه، فإن التضحية لصالح المجموع تُثبت أن الذي يقدّم من ذاته لآخرين قد لا يعرفهم قط، يبلغ المنزلة العليا، منزلة الإنسان ـ المجتمع.
والتضحية درجات تتفاوت بين إنسان وآخر. أما ما يتربع على ذروة سلم القيم الاجتماعية فهي صفة الفداء. بل أن الفداء هو التضحية بمعناها المطلق، خصوصاً عندما يكون المتحد القومي معرّضاً لخطر وجودي شامل. والموازنة تجري بين أن يكون المجتمع أو لا يكون، بين الرقي والانحطاط، بين المناقب والمثالب، بين الحرية والعبودية... بين الحياة والموت.
الفداء في هذه الحالة يتمظهر بمعادلة حسّاسة وواضحة للغاية. لا حياة للأمة إلا بوجود من يملك الاستعداد والقناعة، شخصاً كان أو جماعة، بأن نتيجة الفداء تستحق الثمن المبذول. وهنا يكون فعلُ الفداء فعلَ حياة لأنه ينطلق من قاعدة أن الفرد يزول أما المجتمع فيستمر ويرتقي.
ولأن الفداء يستهدف الأفضل والأسمى لحياة الأمة، فإنه يتعالى عن الحدثي والراهن ليترسخ في الوجدان القومي. وعندها يتحوّل إلى ظاهرة كامنة يسترجعها الشعب كلما ألمّت به الخطوب وهددته المخاطر. إنها مرحلة التماهي بين فعل الفداء وشخصية الفادي، تماماً مثلما تندمج الأسطورة بالواقع فلا يبقى فاصل بين هذا وذاك.
تاريخنا الحضاري في سورية عبارة عن خطوط ثقافية متواصلة ومتفاعلة: زمنياً منذ انبثاق فجر الحضارة في سومر قبل خمسة آلاف سنة وحتى الثامن من تموز 1949، وجغرافياً من المتوسط غرباً إلى ملتقى ما بين النهرين شرقاً، ومن طوروس شمالاً إلى سيناء جنوباً.
أعطى السوريون القدماء فعل الفداء أبعاداً ماورائية، ورأوا أن دورة الحياة الطبيعية لم تستقم ولن تستقيم، إلا إذا تصدى الإنسان لعوامل الفوضى والخراب التي تهدد النظام الكوني. ونظراً إلى صعوبة هذه المهمة، فقد أنيطت بمجمع الآلهة السوري مسؤولية تحقيق الانتصار على عناصر الفناء. إن تدخل الآلهة في شؤون البشر يؤدي حكماً إلى تقارب الماورائي مع الواقع الأرضي.
نظر الإنسان القديم إلى تبدل الفصول من زاوية الموت والبعث: خريف وشتاء تدخل الأرض خلالهما في ثبات عميق (كناية عن الموت)، وربيع وصيف تخضّر فيهما البيئة وتعطي الأرض خيراتها (كناية عن البعث). لكن هذه التحولات لا تحدث من تلقاء ذاتها، وإنما هي بحاجة إلى عنصر خارجي يعجّل الانتصار على الموت ويمهد الطريق للحياة المتجددة.
احتل الإله تموز (دموزي) مكانة مرموقة في مجمع الآلهة السوري، وانتشرت عبادته في سورية والمناطق المجاورة لها بمسميات متنوعة. فهو تموز ودموزي وآدون وأدونيس...إلخ، يصرعه الخنزير البري فتحزن حبيبته عشتار وترفض قبول غلبة الموت على الحياة. وتتحدى إرادة بعض الآلهة وتنزل إلى العالم السفلي بحثاً عن تموز... وتنجح في إعادته إلى الحياة فتقام له الاحتفالات الدينية والشعبية.
هذه الأسطورة الشعبية تكتنه فعل الموت والقيامة، فعل الفداء من أجل حياة أكثر خيراً وعدلاً. إنه الفداء الذي يُقدمه الفرد عن قناعة كاملة لكي تتألق حياة المجتمع في مسيرتها التصاعدية نحو قيم الحق والخير والجمال.
تحوّلت أسطورة الموت والقيامة إلى منهج حياة على مدى التاريخ السوري. كان شعبنا يستعيدها كلما شعر بأن وجوده المادي أو الروحي بات في ميزان البقاء، فيبادر شخص أو جماعة لتقديم فعل الفداء الأكبر. وعلى رغم أن الفداء/ التضحية يرتبط في أحيان كثيرة بالمنحى الديني (المسيح، عاشوراء... إلخ)، إلا أنه في مغزاه الحقيقي شأن قومي واجتماعي من الدرجة الأولى.
وللتضحية شروط مُلزمة، أولها أن يوجد شخص يمتاز بخاصية إستشراف الوضع الذي تمرّ به الأمة. الشخص "الرائي" يعرف ما الذي جلب على شعبه هذا الويل، ويؤمن بأن مسؤوليته الاجتماعية المباشرة هي رفع الويلات عن كاهل الناس: "ومهما كانت الصعوبات، فإني مصمم على مواجهة المهاجرين بالعزيمة نفسها التي واجهت فيها الوطن ووجهه متجهم كالح، وحالته حال فرضت اليأس على الجميع. وإني واثق بأني سأتمكن من تغيير أمور كثيرة". (الأعمال الكاملة، الجزء التاسع، صفحة 83).
عندما أدى سعاده "الرائي" قسم الزعامة في إطار التعاقد بينه وبين المقبلين على الدعوة القومية الاجتماعية، استعمل العبارة التالية: "أنا أنطون سعاده، أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أن أقف نفسي على أمتي السورية ووطني سورية، عاملاً لحياتهما ورقيهما...". ولا شك في أنه كان مدركاً تماماً للمضامين الروحية والتبعات المصيرية المرتبطة بكلمة أقف.
أسس سعاده الحزب ليكون حاضناً للنهضة القومية، وليس مجرد أشكال تنظيمية جامدة. فالغاية الأساسية هي "بعث نهضة قومية اجتماعية...". وكلمة بعث هنا لها أهمية كلمة أقف التي ذكرناها أعلاه. فقد وجد سعاده الأمة في حالة موات وانحطاط، "فمن الداخل نفسية عهد الانحطاط الفاقدة الثقة بمواهب شعبها ومصير أمتها، المستسلمة لعوامل التفسخ والتفكيك والتفريق". (نداء أول حزيران 1940). فالعلاج من وجهة نظر سعاده يقوم على بعث الأمة، أي قيامتها من الموت.
هذا هو الصراع المصيري الحتمي، كما يراه سعاده، صراع بين عالمين "هما عالم النهضة القومية الذي رأى النور في سورية وأخذ يغذي أمم العالم العربي بمبدأ القومية الذي يعني مبدأ التقدم والارتقاء. وعالم التقاليد الرجعية الدينية والاقطاعية الذي أنشأ لنفسه منذ القدم حصوناً قوية في سورية يدافع فيها عن مبدأ الدولة الدينية أو التيوقراطية، وينادي أمم العالم العربي للتشبث به". ("الزوبعة"، العدد 25 تاريخ 1 آب 1941).
أقسم سعاده على أن يعمل لحياة سورية ورقيها. آمن بأصالة شعبه وطبيعته الطيبة، وجاهد لتخليصه من براثن النفعيين وسيطرتهم. وعمل طيلة سنواته لكشف الطريق القويم نحو الحياة المثلى، مؤكداً: "إن لي ثقة بوجود نفوس كبيرة نبيلة تميّز بين النور والظلمة، وتعمل في النور لنشر النور". (رسالة إلى نعمان ضو، الأعمال الكاملة، جزء 9 صفحة 99). عامل الثقة ومعه عامل الإيمان شكلا الدافع العقلي والوجداني لمسار سعاده نحو فعل التضحية وفعل الفداء.
لم يخادع سعاده أحداً، ولم يعدنا بالمكاسب الشخصية. قال لنا إنه لم يأت بالخوارق والمعجزات وإنما فتّح أعيننا على الحقائق التي هي نحن. وضع أمامنا خيارين مفصليين لا مفر من التعامل معهما: "مصير النعرات الدينية والتقاطع والسقوط، أو مصير النهضة السورية القومية ووحدة الإرادة والقوة والنصر". (نداء أول تموز 1939).
وبالنسبة إلى سعاده، فإن مجالات المعركة كما وصفها في قصة "فاجعة حب" هي: "الصراع بين عهد الخمول وعهد التنبه والنهوض، العراك بين الأنانية والخير العام، بين المادية الحقيرة والنفسية السامية، بين الحيوانية والإنسانية، بين الرذيلة والفضيلة...". وكان رهانه الدائم أن الشعب السوري سيختار طريق الحياة تحت جناح الفكر القومي الاجتماعي، وأن دوره كمؤسس وزعيم "وضع حد لفوضى العقائد القومية في المجتمع السوري وتوحيده في عقيدة كيانه ومصلحته، وصرفه عن التخيلات العقيمة والأوهام الاتكالية إلى التفكير العملي والعمل والنهوض بالذات، وتعويد النشء، خصوصاً، ممارسة الحقوق والواجبات القومية والفضائل التي توّحد المجتمع وترقيه في نظرياته وأنظمته". (الأعمال الكاملة، الجزء السابع، صفحة 18).
لعل سعاده أدرك في سنواته الأخيرة أن جذور الفساد ضربت عميقاً في النفسية العامة: "فليس، ولم يكن قط، للفوضى التي تتخبط فيها الأمة السورية مثيل، ولم يبلغ الفساد في أمة من الأمم، في أي وقت من الأوقات، مبلغه في أمتنا إلى هذا الوقت". (الأعمال الكاملة، الجزء الثامن، صفحة 224). لم يكن سعاده ينتظر أن تكون الطرق مشرّعة أمامه، ولكن في الوقت ذاته صدمه تفشي نفسيات الانحطاط والخيانة والغدر. فكان يعزّي نفسه بـ"أن تحت الرماد لناراً، وأن تحت طبقات الذل والخنوع لقوى جديدة وعوامل جديدة تتهيأ ليوم عظيم مشهود، وأن وراء النيات لعزائم تُفني الأسباب ولا تفنى وتحوّل الأزمنة ولا تتحوّل". (الأعمال الكاملة، الجزء السادس، صفحة 432).
إستند سعاده في ثباته عند مواقفه وقناعاته على: عقيدة قومية اجتماعية نابعة من حاجات الأمة، وعلى بطولة القوميين الاجتماعيين المؤيدة بصحة العقيدة، وعلى قيادة زعيم أوقف نفسه على حياة الأمة ورقيها... وفي حال إحتياج الأمة إلى وقفة عز استثنائية، فإن سعاده يختزن في شخصيته ووجدانه فعل التضحية والفداء المنحدر إلينا من تراثنا السوري العريق.
لكن قوى الشر والغدر والخيانة تكالبت على سعاده فور كشفه عن رغبته بالعودة إلى الوطن طالما أن الحرب العالمية الثانية قد أنتهت، وهي التي فرضت عليه البقاء في المهجر القسري منذ العام 1939. تجاوز سعاده معضلة الحصول على جواز سفر بمساعدة الرفقاء في البرازيل. ثم أحبط في القاهرة مساعي نعمة ثابت وأسد الأشقر لثنيه عن الصدام مع الحكومة اللبنانية. وأخيراً حطت طائرته في مطار بيروت ليلاقي أكبر استقبال شهده الكيان اللبناني حتى ذلك التاريخ.
كانت مشاعر سعاده تتراوح بين طرفي نقيض: اليقين والشك، الأمل واليأس، النجاح والإحباط... كتب يقول بينما كان يستعد لمغادرة الأرجنتين: "ولقد قضيت وسط النزالة السورية في هذه البلاد نحو سبع سنوات، فيا لضياع ما خطبت وما كتبت وما نفخت وما جمعت. كله كان عبثاً. ولولا أملي بما أنشأت في الوطن وبأفراد قلائل واعين في المغترب لصمتُّ كل الصمت وأعفيت نفسي من هذا العناء الباطل". (الأعمال الكاملة، الجزء العاشر، صفحة 511).
لكن الغلبة في وجدان سعاده كانت لفعل التضحية والفداء، لأنه "إذا تركت سورية الفرص الحاضرة والآتية قريباً تمر بلا فائدة لها، فليس من باب المبالغة القول إنه يكون في ذلك القضاء على أمل سورية بالحرية إلى أجيال وأجيال. وقد يكون في ذلك القضاء على الأمة السورية قضاء مبرماً". (الأعمال الكاملة، الجزء السادس، صفحة 432). وما كان لسعاده، الذي أوقف نفسه على وطنه سورية، إلا أن يقدّم وديعة الأمة في الثامن من تموز.
صحيح أن قوى الشر والغدر والخيانة كسبت تلك الجولة، لكن دماء سعاده تبقى الوقود الذي يستنهض في القوميين الاجتماعيين تراث الأمة التاريخي حيث القيامة هي الانتصار النهائي على الموت.
التاريخ: 2023-07-12
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro










