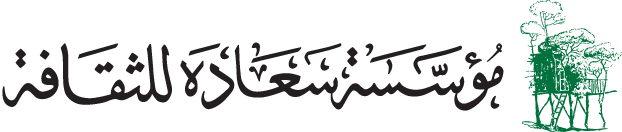نواف سلام وصراعه مع الأنظمة الطائفية
يواجهُ لبنان وأقاليم المشرق استحقاقات أساسيَّة ومصيريَّة كثيرة، أهمُّها تحريرُ التراب المستَباح من قبلِ العدوِّ والقوى الاستعمارية، وبناء سلطة الدولة في حفظ استقلالية القضاء، وتثبيت الأمن، والقضاء على الطائفية، والمحسوبيَّة، والفساد.
وكانت الوسيلة المعلنة من العهدِ الجديد في لبنان الابتعاد عن المحاصصات الطائفيَّة، والاعتماد على الكفاءات، وَوُجِدَ بأنَّ هذا لا يكفي. فلم يكن من السهلِ تأليف تلك الحكومة بلا تلبية طلبات القوى الطائفية المتحكِّمَة في اللعبة السياسية، في خضوعها للإملاءات الطائفيَّة. وبعد تَعثُّرٍ، تألّفَت الحكومة الموعودة، وأعلنت الأحزاب الطائفية المتناحرة انتصارها، وكلُّ واحدٍ منها ما زال وراء متراسه.
أمّا الأحزاب العَلمانية والوطنية فاستُبْعِدَتْ، حتى من التشاور! فعلى من تقعُ الملامة في هذا التراجع والانحسار؟ التنظيمات الطائفيّة نفسها في ولاءاتها الخارجيَّة، وفي شبقها إلى السلطة، وفي صراعها المحموم عليها وبين بعضها البعض، هي المسؤولُ الأول.
في مقاله في صحيفة «الأخبار» نهار السبت الثامن من شباط 2025، وتحت عنوان «مات الملك عاش الملك»، كَتَبَ المفكر القومي الاجتماعي بدر الحاج كيف تتبدَّلُ مواقفُ السياسيين قائلاً: «معظم تجار السياسة والطامحين إلى المناصب في بلادنا يُبَدِّلون مواقفهم كما يُبَدِّلونَ أحذيتهم، يَسْتَديرون مع كلِّ ريحٍ تهُبُّ.
السلطةُ والنفوذُ هما الهدفُ... المهمُّ الوصولُ إلى منصبٍ وإعلان تأييدٍ مطلقٍ لمن أوصَلَهُم... تاريخ لبنان حافلٌ بأمثال هؤلاء المرتدّين، ولكلٍ منهم أعذاره وتبريراته. وفي المحصِّلة الأخيرة، هم، كما وَصَفَهُم أنطون سعادة، مُجَرَّدُ مجموع أشخاصٍ يساوي قضايا شخصيَّة. الأشخاص، مهما كانوا متعلمين واختصاصيين، لا يخرجون عن كونهم أشخاصاً تُسَيطرُ على ممارساتهم قضاياهم الشخصية وغاياتُهم الفردية»؛ ويُدرجُ أمثلةً على ذلك.
وهكذا جاءت الأوامر من مصادرها المعتادة والمعروفة، والمُسَلَّمِ بها، وتغيَّرَت المواقف.
الدكتور هشام شرابي، في كتابه «المثقفون العرب والغرب» الصادر عن «دار النهار» عام 1971 قال: «إن انهماك ذوي الفكر والاختصاص (في بلادنا) لا يرتكز في العمل لأهدافٍ اجتماعية يغنى بها المجتمع، بل في السعي وراء الرزق والمصلحة الفردية...»، وهذا ما سمّاهُ «عُبودية الارتزاق».
والملامة أيضاً تقعُ على الأحزاب العَلمانية الوطنية، التي، خلال السبعين سنة الماضية، كانت قياداتُها منهمكةً في صراعٍ مُدَمِّرٍ، بعضها مع بعض، ولمدة طويلة ولهدفٍ واحدٍ هو وصولُ كلٍّ منها إلى السلطة.
التاريخ الطويل لقيادات الأحزاب العَلمانية في الفشل وفي الأزمات المتعاقبة يرجعُ سببه إلى اعتقادها بأنّ الحلول هي الحلولُ السياسية السريعة، وهي لا تأتي إلّا باجتراح العجائب؛ ولاجتراح العجائب لا بد من مخلِّصٍ أو ساحرٍ أو بطلٍ خارق كبّروا هالته لتعبئة الجماهير وراءَه، وللوصول إلى السلطة بأقصر الطُّرُق. هاجسُ السلطة هذا جعلها شرسة في شهواتها. وقد فشلت هذه الأحزاب في خلق مشروعٍ وطنيٍّ واحد ما بينها، لا بل زاحم بعضُها بعضاً في التحالف مع النُّظُم الديكتاتورية، وانبرت إلى المغامرات السياسية بالاشتراك مع بعض السياسيين البهلوانيين في المنطقة، متسلّحة بـ«المنطق» العسكريتاريّ، وبقعقعة البسطار، وامتطَتْ في «غزواتها» التنظيمات الميليشياوية.
أمّا العمل النهضوي في بناء المجتمع وتحصينه بالمؤسسات المدنية والاقتصادية وبالمعرفة والثقافة، فلم يكن ظاهراً في عملها وأدائها وتمَوْضعها السياسي. هذه الأحزاب هَمَّشَت النخبة الفكرية وأبعدتها عن مشاريع النهضة والتطوُّر.
وعصرُ بيروت الذهبيُّ، في الصحافة والأدبِ والشعرِ والمسرحِ والموسيقى والغناء والرسمِ والنحت، بين عامي 1950و1975، أي «عصر الحداثة»، كان أصحابُ الرؤية والفكر أعمدتَه، إلى أن جاء ملوك الطوائف وقضَوا عليه.
وهنا يحضُرُني حديثٌ للموسيقار منصور الرحباني أجريته معه في ربيع عام 1996 لمجلة «الحكيم»، التي كانت تصدُرُ عن منظمة الأطباء العرب الأميركيين، قالَ فيه: «خسرنا معركة المدفعِ، والمدفَعُ لم يكُن كفُؤاً، ولن يكونَ اليومَ. يجبُ ألّا نخسرَ معرَكَةَ الفكرِ والعلم والبناء. كفاءَاتُنا ستمكِّننا من القبض على زمام الأمور. يجب ألّا ينحسِرَ العنفوان الحضاري عن أرضنا؛ وإن انحَسَرَ فسيطغى علينا العدوُّ اقتصاديّاً». «حفروا خنادقَ وتمركزوا فيها، ومن جرّاءِ ذلك جرَّدوا القواعد من إمكانيّاتها الفكريَّة والابتكاريَّة، فداهمتهم رغبة الهجرة ومرارة الاغتراب».
أمّا الرئيس نَوّاف سلام، وتجاه هذا التجاذب العقيم، فلا يمكننا، ولا يمكنه، تجاهلُ تاريخه وتاريخ أصحابه النضالي الماضي. فهو يعرف أنَّ مشكلة الكيان اللبناني لا تنحصرُ في التحدِّيات الداخلية، كإعادة بناء الاقتصاد، وحماية مدَّخرات الناس المودَعة في المصارف، والقضاء على الفساد... وإنما التاريخُ والجغرافيا يتطلَّبان من الكيان اللبنانيّ التزاماتٍ إقليمية، ونضالاً صلباً في الصراعات بين الأمم. هناك عدُوٌّ شرس، وترابٌ مُحْتلٌّ، وقوى إقليميَّة لا تقلُّ شراسةً في أطماعها في أرضنا.
في ضوء معرفتي ومعرفة الناس بالرئيس نوّاف سلام وكفاءاته القانونية لا يمكن تجاهل نضاله السياسيّ، بدءاً من حركة «اليسار الديمقراطي» التي أسّسها الياس عطالله إبّان حرب الـ15 سنة، والتي انخرط فيها الرئيس سلام، وسمير قصير، والياس خوري، وحبيب صادق، وغيرهم، والتي ابتعدَتْ عن مركزية الحزب الشيوعي وعالميته النضالية وإملاءات موسكو، نازِعةً إلى المقاومة الوطنية، والاستقلالية الفكرية، والديمقراطية، والعَلمانية - وتابعتُه في مناظراته ومحاضراته في نيويورك أثناء ترؤُّسه بعثةَ لبنان إلى الأممِ المتَّحدة، وانتمائه إلى النخبة الفكرية في المهجر الأميركي، وتشرَّفتُ، معَ بعضِ الأصدقاء من الجالية، بدعوته لنا إلى عشاءٍ في بيته في نيويورك - في ضوء كلِّ ما تقدّم، ليس من الممكن لنوّاف سلام أن يكون صانعاً لهذه الحكومة، لا بل ظاهرٌ ومنطقيٌّ الجزمُ بأنَّها فُرِضَتْ عليه. والسؤال هو: إلى أيِّ حدٍّ يستطيعُ هذا العَلمانيّ الوطنيّ تعبئة وزرائه، كورشةٍ تعاونيَّة عاملة، للابتعاد عن ضغوط السياسيين الطائفيين؟
ما يُرعبُ الدولة والناس نَبَّهَ عنهُ أنطون سعادة منذ أكثر من مئة سنة، في مقالٍ كتبه في جريدة «الجريدة»، سان باولو، بتاريخ الأول من تشرين الأول عام 1921، مُحَذِّراً فيه من أن التعصب الدينيَّ والصهيونيَّة سيجلبان على الشعبِ ويلاتٍ لا تُحصى (الآثار الكاملة، ج1، ص:11)؛ وهذا ما يحدثُ اليوم. وقد أكّد ذلك في ثلاثة من مبادئه الإصلاحية: «فصل الدين عن الدولة» و«منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين» و«إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب». فمن هو الحزبيُّ أو غيرُ الحزبيِّ الذي لا يوافق على هذه المبادئ!
ثمّ إن سعادة هو الذي آمنَ بتحرير الأرض، وببناء شرعية الدولة الوطنيَّة، وترميم الاقتصاد الوطني. قال: «الاقتصادُ ارتقاء» ورَبَطَ الاقتصادَ بالإنتاجِ: «كُلُّ عضوٍ في الدولة يجب أن يكونَ مُنْتِجاً بطريقةٍ من الطرق». والإنتاجُ «هو حقٌّ عامّ لا حقٌّ خاصّ».
ويجب توزيع الثروة على أساس هذا الإنتاج. «المصالِح ليست مجرَّد منافع. المصالح هي مصالحُ الارتقاء والفن، مصالح جمال الحياة كما هي مصالح الاقتصاد والصناعات والتجارة، المصالح المادية التي يتوقف عليها المجتمع مادياً». والحقيقة هي أنَّ الإنتاج يَتَطَلَّبُ كفاءات مختلفة، تتوظَّفُ وتستثمِرُ في مشروعٍ معيَّن: و«ما من عملٍ أو إنتاجٍ في المجتمع إلّا وهو عملٌ أو إنتاج مشترك أو تعاوني».
إنَّ الأمرَ يتطلَّبُ قيادةً رؤيويَّة تتخطى الحالة الرديئة الراهنة، وتستشرفُ المستقبل.
هناك حاجةٌ إلى قيادة قادرة على تعبئة الصفّ كلّه بالالتزام بالنظام «منعاً للفوضى»، لتحقيق الغاية، في التصميم والممارسة والأداء المنتج. وهذا يتَطَلَّبُ ورشة عملٍ تعاونية من الكفاءات لا تخضعُ للإملاءات الطائفيَّة، ولا للمصالح الشخصيَّة. فهل يستطيع الرئيس نوّاف سلام (هو ورئيس الجمهورية عَيَّنا 62% من الوزراء) تعبئة وزرائه، بكفاءاتهم، في مشروع إصلاحي كما هو مأمول؟
* كاتب وطبيب
التاريخ: 2025-02-20
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro