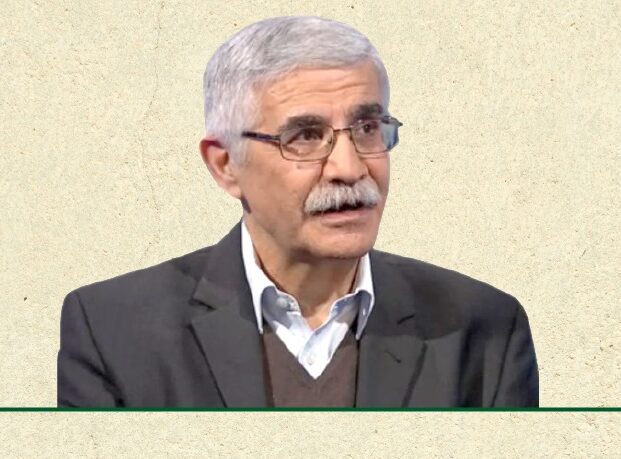
التعاون، التحالف، الارتهان، التبعية
لماذا تضطر الأحزاب السياسية، سواء في النظم الديموقراطية أو الشمولية، إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى تتمايز عنها في أفكارها وممارساتها وغاياتها؟
قبل الشروع في محاولة الإجابة على هذا السؤال، لا بأس من إيراد حادثة طريفة رواها لي صديق عراقي. ومع أني لست متأكداً من مدى دقة تفاصيلها... غير أنها تبدو لي صحيحة في عراق تلك الفترة العصيبة. يقول الراوي: بعد أن سمح حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في بغداد للحزب الشيوعي بالعمل العلني في إطار الجبهة الوطنية، قرر الشيوعيون إفتتاح مقر رسمي، وطلبوا من أحد الخطاطين رفع يافطة باسم الحزب فوق مدخل المبنى. وبينما هذا الخطاط منهمك في عمله، إذ بدورية من المخابرات تصل إلى المكان لتفقد الوضع. فما كان من هذا الخطاط المسكين الذي استولى عليه الرعب إلا أن واصل عمله تاركاً اليافطة على الشكل التالي: "مقر الحزب الشيوعي العراقي... لصاحبه حزب البعث العربي الاشتراكي"!
نعود إلى السؤال المطروح أعلاه كي نحاول الإجابة بقدر ما تسمح به هذه العجالة، وبما يفيد في تفهّم الترتيبات الحزبية والسياسية التي تجري من حولنا الآن.
تُقدم الأحزاب السياسية على عقد التحالفات في حالة من ثلاث:
الأولى، ظهور تطورات خطيرة تمس المصلحة القومية العليا ما يتطلب رصّ الصفوف الداخلية بهدف درء المخاطر الخارجية. وتنخرط الأحزاب كلها في هذا التحالف، بغض النظر عن تناقضاتها العقائدية.
الثانية، عدم قدرة هذا الحزب أو ذاك على الحكم منفرداً بسبب فشله في الحصول على الأغلبية البرلمانية (وهذا يكون أساساً في الأنظمة الديموقراطية البرلمانية حيث يتم تداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع). والتحالف في هذه الحالة مؤقت، بانتظار الجولة المقبلة من الانتخابات كي يعود كل طرف إلى قواعده سالماً.
والثالثة، فشل الحزب الحاكم خصوصاً في الأنظمة الشمولية بعد سنوات من التفرد في السلطة، فيلجأ إلى تشكيل "جبهة وطنية" بهدف إمتصاص النقمة الشعبية. وفي الوقت نفسه يكون قد وزع تداعيات فشله على الأحزاب الأخرى التي لم يكن لها أي دور في وصول الأمور إلى ما آلت إليه في ظل سيطرة "الحزب القائد"!
طبعاً هناك حالات أخرى، لكنها تندرج إجمالاً في خانة من الثلاث التي ذكرناها هنا. وهي لا تُغيّر كثيراً في تفهم النتائج الناجمة عنها.
التعاون هو الشكل الأولي لقيام علاقات بين الأحزاب ذات الإيديولوجيات المتباينة. وغالباً ما يتمحور حول أهداف مرحلية آنية لا تُلزم الأطراف المتعاونة بأي شأن أخر عدا موضوع التعاون بحد ذاته. من الأمثلة المعبّرة الانتخابات البلدية أو النيابية أو النقابية. يتفق حزبان أو أكثر على التعاون لخوض المعركة الانتخابية من أجل هزيمة الجهة المنافسة، وتحقيق أوسع قدر ممكن من المكاسب. وبعد ظهور النتائج، يذهب كل طرف في حال سبيله بغض النظر عمّا أسفرت عنه صناديق الاقتراع. وغاية هذا النوع من التعاون في الأساس هو الفوز، لأن أياً من أطرافه لا يضمن النجاح منفرداً. ومن المفترض أن تمتلك الأحزاب الراغبة بالتعاون حداً أدنى من العناصر المشتركة، لكن هذا ليس شرطاً مسبقاً.
أما التحالف فهو مسألة أكثر تعقيداً، لأنه يستدعي السعي إلى قواسم مشتركة فكرية وسياسية يلتقي حولها الطرفان (أو أطراف عدة)، ويلتزمان بالعمل على إنجاز الغاية الرئيسية من برنامج التحالف. وهذا السعي قد يتطلب، في أحيان كثيرة، أن يتنازل المتحالفان عن بعض مسلماتهما السياسية لصالح مسلمات جديدة من الطرفين تصبح هي قاعدة الانطلاق في حراكهما. وهناك احتمال كبير في أن تبتعد مسلمات التحالف عن مسلمات كل من الجانبين. وسيحدث هذا فعلاً إذا اختلت التوازنات داخل التحالف، وحاول الطرف القوي أن يفرض على الآخرين وجهة نظره وآليات عمله. ولكي يتم تجنب الوقوع في هذه المعضلة، يصبح من اللازم والملح أن يتوصل دعاة التحالف إلى تفاهمات جلية وشفافة يلتزم بها الجميع من دون طغيان طرف على آخر. ولنا في تجربة التحالف بين الحركة الوطنية اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينات القرن الماضي نموذجاً مثالياً لما عرضناه.
الارتهان هو التحالف عندما يتعرض لخلل في الممارسة. ذكرنا أعلاه أن التحالف المتين يشترط الوضوح في الغايات والالتزام بقواعد العمل. لكن غالباً ما يتبدل الوضع بحيث يرتهن الطرف الأضعف للطرف الأقوى بشكل أو بآخر. عندها تتراجع الإرادة المشتركة، وبالتدريج يسيطر الذي يملك الإمكانات المادية والسياسية على قرار "التحالف" حتى ولو على حساب المبادئ الأساسية التي تميّز شخصية طرف عن آخر. وفي وضعية الارتهان هذه، سيكون التحالف أمام معادلة جديدة: طرف مهيمن قادر على إنجاز كامل الأهداف التي أنشيء التحالف من أجلها. وطرف آخر خاضع ومجبر على قبول مواقف وممارسات تناقض توجهاته الفكرية والسياسية والاجتماعية. ومن المحتمل أن تحدث خلافات داخل هذا الطرف، فتندلع صراعات داخلية، مع ما يرافقها من انحرافات وانقسامات تسفر عن انشقاق الصف الواحد وشرذمة الأعضاء. وتنطبق هذه الصورة على السطوة التي امتلكتها حركة "فتح" ضمن التحالف اللبناني ـ الفلسطيني آنذاك. ويمكننا أن ندرج في هذه الخانة تجربة الجبهة الوطنية التقدمية التي لجأ إليها جناحا حزب البعث الحاكمان في دمشق وبغداد، حيث حظرا على الأحزاب الأخرى المشاركة في الجبهة القيام بأي نشاط بين الطلاب أو داخل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة!
وأخيراً نصل إلى حالة التبعية التي هي "أعلى مراحل الارتهان". ذلك أن سريان عقلية الارتهان، وعجز قيادات الطرف المُرتهَن عن استعادة التوازن في علاقات التحالف، سيؤديان حكماً إلى التبعية العمياء. ويحدث في كثير من الأحيان أن تتقاطع المصالح الفردية مع عوامل الإفادة الشخصية التي يؤمنها الارتهان، فتتسارع وتيرة التبعية في طريق ذي اتجاه واحد! وعندما يصل طرف ما إلى هذه السوية، فإنه يفقد شخصيته المميزة ويتنازل عن إرادته المستقلة، ويتحوّل إلى مجرد ملحق لا شأن له ولا قرار في علاقة أحادية الجانب. ويصبح من الصعب التفريق بين الطرفين حينما يتماهى الأضعف مع الأقوى، وتضيع في حمى المنافع الفردية المبادئ الأصلية التي على أساسها كان التحالف في الدرجة الأولى. ويكمن الخطر في علاقة التبعية هذه أن الجانب الأقوى والمستقوي بإمكانه "توظيف" الجانب التابع القانع لتنفيذ مهمات "قذرة" لا يريد هو أن يلوّث يديه بها! فينتهي الأمر بهؤلاء "الضعفاء" ليكونوا مقاتلين بالإيجار... مجموعة مرتزقة تتلطى خلف شعارات برّاقة وكاذبة!
التاريخ: 2021-05-31
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro










