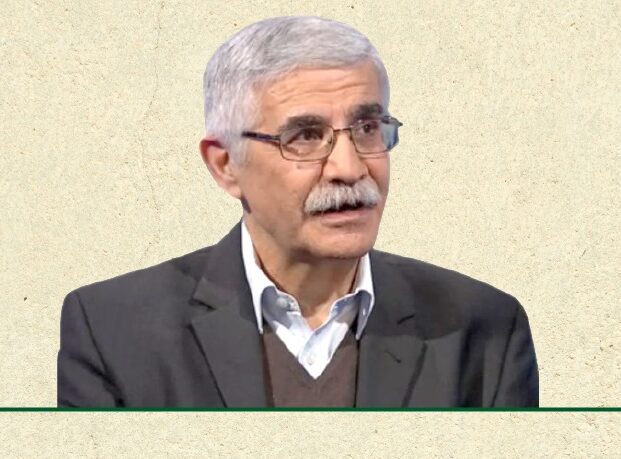
عودة "الغرب" العجوز إلى صباه الاستعماري
... أخيراً شمّرت أوروبا عن سواعدها، ومطمطت بعضلاتها، وكشّرت عن أنيابها، وأعلنت أنها قررت تفعيل "خططها" المخصصة لمنطقة المحيط الهادئ ـ المحيط الهندي. وقد نجحت الدول الأكثر حماسة للتدخل، فرنسا وألمانيا وهولندا، في إقناع الاتحاد الأوروبي بتبني مخططات تغطي مجالات عدة تبدأ بالمشاريع الأمنية وصولاً إلى الشؤون الصحية، وبينهما مروحة من المسائل المتنوعة. والهدف من ذلك حماية "مصالح" أوروبا في تلك الأنحاء، وفي الوقت ذاته كبح جماح الصعود الصيني المستمر. والغريب أن المسؤولين الأوروبيين يحرصون على التأكيد بأنهم لا يصوّبون ناحية الصين، بل يزعمون بأن غايتهم نشر الديمقراطية وتدعيم الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. وبهذا يكون "الغرب" قد عاد مرّة أخرى إلى مجاله الاستعماري السابق... إنما تحت شعارات تناسب القرن الحادي والعشرين.
ومن المناسب أن أوضح أولاً أنني حينما أستعملُ مفردة "الغرب" في سياق البحث السياسي الاستراتيجي، فأنا لا أقصد الجانب الجغرافي المتعارف عليه، ولا الثنائية الحضارية التي تتكرر بين حين وآخر "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً". الغرب الذي أعنيه هو الإطار الأشمل الذي يجمع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا (الاتحاد الأوروبي والحلف الاطلسي) إضافة إلى دول أخرى متحالفة أو مرتبطة مصلحياً مع الولايات المتحدة. هذا "الغرب" يتحرك كتلة واحدة متراصة في المسائل الاستراتيجية، ويتبع قرارات واشنطن سواء تعلقت القضايا المطروحة بالدول المعنية مباشرة، أو كانت لا تمسّ مصالحها الذاتية. إنها عقلية إنصر أخاك ظالماً... وظالماً أكثر.
هذا "الغرب" لا يملك إلا أن يكون معتدياً. خلال القرون الثلاثة المنصرمة كان الاستعمار المباشر واستعباد الشعوب، وإبادتها في أحيان كثيرة، هي المخارج التي تنفّس عن الاحتقانات الاجتماعية في القارة الأوروبية العجوز. ذلك أن الثورة الصناعية أفرزت تناقضات حادة في المجتمعات الغربية، كانت السبب في حروب متواصلة بين الأوروبيين أنفسهم. وترافقت تلك الحروب مع توجه إلى الاستعمار الخارجي الذي أصبح الوسيلة الأساسية لجني الثروات، ما ساعد في توظيف قسم منها لرفع مستويات المعيشة في أوروبا. ولا شك في أن عائدات الاستعمار من جهة، وحركة استيطان الأوروبيين في العالم الجديد من جهة أخرى، خففت الضغوطات الداخلية... لكنها رسّخت عقلية التسلط والهيمنة.
وفي كل مرحلة من تاريخ الاستعمار، كان "الغرب" ذكياً في إيجاد المبررات والذرائع. وما زال على هذه الخصال حتى يومنا هذا. ولن نوغل بعيداً في الماضي، وإنما سنعود قليلاً إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية لأن الجغرافيا السياسية كما نعرفها حالياً تكوّنت يومذاك. المنتصرون في الحرب أنقسموا إلى معسكرين، سرعان ما نشبت بينهما "حرب باردة" قطباها الرئيسيان: الولايات المتحدة الأميركية على رأس المعسكر الرأسمالي، والاتحاد السوفياتي يقود المعسكر الاشتراكي. وزوّد هذا الصراعُ "الغربَ" بعدو جاهز، وفّر للمخططات الغربية تغطية على مدى خمسة عقود تقريباً. وكما نعلم جميعاً، فاز المعسكر الرأسمالي على خصمه الاشتراكي بالضربة القاضية مطلع تسعينات القرن الماضي... فتغيّرت الجغرافيا السياسية جذرياً.
عندما سقطت التجربة الشيوعية في شرق أوروبا، وانهار الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى قادرة على تحدي "الغرب"، سارع المنظرون الغربيون للبحث عن "خطر جديد" بديل عن الخطر الشيوعي كي يشد العصب الرأسمالي الذي تراخى نسبياً بعد انتصاره الناجز! ولعل المفكر الأميركي صموئيل هانتغتون كان أبرز الذين عبّروا عن التوجه المطلوب، من خلال نظريته في "صراع الحضارات" المنشورة سنة 1993 في مجلة Foreign Affairs. وكان يقصد بالطبع أن "الحضارة الغربية" المنتصرة في الحرب الباردة ستواجه مستقبلاً حضارات أخرى معادية، منها "الحضارة الإسلامية". والخطير في هذه النظرية قول هانتغتون: "... ينبغي أن يبذل الغرب جهداً لترسيخ قيمه في الديمقراطية والحرية باعتبارهما قيمتين عالميتين، وذلك لإبقاء سطوته وهيمنته العسكرية وتوسيع مصالحه الاقتصادية". (قارنوا هذا القول بقرار الاتحاد الأوروبي أعلاه)
أدت نظرية "صراع الحضارات"، المدعومة بتيار المحافظين الجدد في أميركا، إلى تحديد عدو جديد هو "الخطر الإسلامي". وتم توظيف الآلة الإعلامية الغربية لترسيخ هذا الشعار والترويج له على كل المستويات. والمثير في الأمر أن الحملة الإعلامية المبرمجة عتمّت على تاريخ العلاقة بين "الغرب" وحركات "الإسلام السياسي" عندما شكلا تحالفاً وثيقاً في معركة إخراج السوفيات من أفغانستان. عناصر "الخطر الإسلامي" المستجد هم أنفسهم "المجاهدون" الأفغان الذين تمتعوا بأعلى درجات المساعدة والتمويل والتسليح والدعم الأمني. وكانت واشنطن وحلفاؤها يعرفون حق المعرفة طبيعة القاعدة الفكرية المتطرفة التي ينتمي إليها "المجاهدون". لكن يبدو أن هزيمة الاتحاد السوفياتي برَرت للغرب التحالف حتى مع الشيطان!
دعونا نتجاوز سريعاً عن فترة "الحرب العالمية على الإرهاب" مطلع الألفية الحالية، والتي وُظفت لتأمين إنتشار القوات العسكرية الغربية من القرن الأفريقي إلى أفغانستان، مروراً بالخليج العربي (سنعود إليها بمقال منفصل). ذلك أننا لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية تغييراً في أولويات الغرب الاستراتيجية، يتماهى مع الانخراط الأميركي في مناطق جنوب شرق آسيا. وما قرار الاتحاد الأوروبي بتعزيز نشاطاته في منطقة المحيطين الهادئ والهندي سوى مظهر أولي لانتقال مركز الثقل الغربي نحو جبهة جديدة. ويجب أن نتذكر أن الرئيس الأسبق باراك أوباما هو الذي أعلن تلك الاستراتيجية سنة 2009، ولم يشذ الرئيس السابق دونالد ترامب عن مسارها المرسوم. أما الرئيس الحالي جو بايدن فقد كان نائباً للرئيس عندما ظهرت الخطة إلى العلن.
وكما كان يحدث في كل الصراعات التي خاضها الغرب، بتنا نسمع خطاباً إعلامياً وتعبوياً مختلفاً عما عهدناه منذ مطلع الألفية الحالية. أول ما يثير انتباهنا أن الإعلام الغربي خففّ أو أسقط من قاموسه مفردات كانت بمثابة محطته الدائمة خلال العقدين الماضيين: عبارة "الحرب على الإرهاب" بالكاد نسمعها هذه الأيام. وصفة "الإرهاب الإسلامي" أصبحت في ذمة التاريخ، إلا في الدراسات الآكاديمية المحدودة الانتشار. وبما أنه لا شيء يحدث صدفة في الإعلام الغربي، فنحن نعتقد بأن هذا المنحى يتعلق بالأهداف الاستراتيجية المتغيرة. فقد باتت هناك ضرورة للاستفادة من "أخصام" الأمس للتنغيص على "أعداء" اليوم: الصين وروسيا، أولاً وأخيراً!
الحملة الغربية على الصين سياسياً وإعلامياً تركز على نقاط عدة (من وجهة نظر الغرب): نظام الحزب الواحد، تقييد الحريات في هونغ كونغ، انتهاك حقوق الإنسان، والمعاملة القاسية التي ترقى إلى مصاف الإبادة للمسلمين الإيغور... وقد بلغ التهجم حداً شخصياً بحيث وُصف الرئيس الصيني تشي جينبينغ بالتنين الذي "يفتك بكل من يقف في طريقه". لكن مشكلة الإيغور تحتل مرتبة رفيعة في خطط الغرب الموجهة ضد الصين. وهذا يعني العودة إلى دغدغة المشاعر الدينية الإسلامية كما حدث في أفغانستان... لكن هذه المرّة ضد الداخل الصيني (وإلى حد ما ضد الداخل الروسي: الشيشان وداغستان على سبيل المثال).
ويرى المخططون الإعلاميون في "الغرب" أنه سيكون من غير الطبيعي الاستمرار في التحذير من "الإرهاب الإسلامي"، في حين أن التحدي الأكثر حساسية وإزعاجاً لبكين هو الضرب المتواصل على وتر الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون. إذن هناك حاجة حيوية للتعامل مع جماعات "الإسلام السياسي"، وتطويعها في التحركات المنظمة ضد الصين. ربما تقتصر الخطة التمهيدية على التشهير الإعلامي والإحراج السياسي، غير أنها يمكن أن تنتقل بقدرة "قادر" إلى أعمال أمنية على غرار ما عانت منه دول عدة خلال السنوات الماضية. إن المراقب السياسي يستطيع تلمس بوادر ذلك التغيير، خصوصاً في الظواهر الإعلامية. ولن نستهجن أبداً إذا ما أطل علينا قريباً أفرقاء تعودوا نقل البندقية من كتف إلى كتف حسب الطلب!
التاريخ: 2021-05-07
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro









