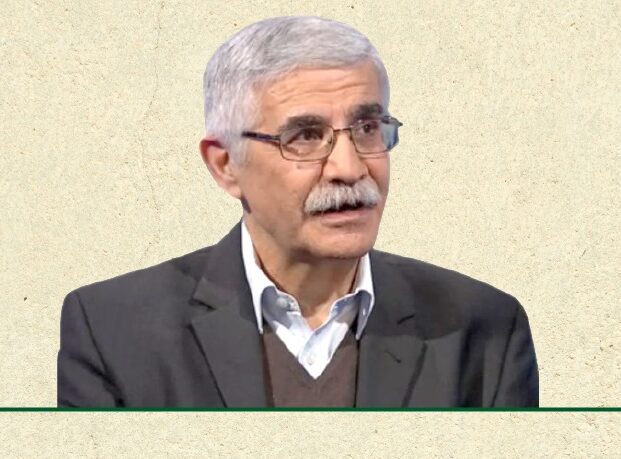
الغرب الأميركي ـ الأوروبي تحت العباءة الإسرائيلية
ما ترتكبه آلة الموت الصهيونية في فلسطين صادم فعلاً، لكنه ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ الدولة العبرية، بل هو نمط راسخ في قلب المشروع الصهيوني منذ بداياته الأولى. إن مبدأ إيقاع أكبر وأفظع الخسائر بين السكان المدنيين يشكل جزءاً من فلسفة الحرب عند الإسرائيليين. ولسنا بحاجة إلى تعداد المجازر التي تعرض لها شعبنا على مدى القرن الماضي، فهي لا تُحصى، وفي معظم الأحيان لم يكن لها مردود عسكري... اللهم إلا الترهيب وزرع الرعب في صفوف المدنيين العزل.
وانطلاقاً من هذه الحقيقة، لا أريد أن أتوقف طويلاً عند المجازر المُرتكبة في غزة خلال الأيام القليلة الماضية. فالعدوان الحالي ليس الأول، وأظن أنه لن يكون الأخير. طبعاً من المهم جداً إيصال الصورة الحقيقية المرعبة إلى المحتمع الدولي، وتحريك الرأي العام للضغط على حكومات ما تزال تغض النظر، أو تتواطأ مع ما تقوم به السلطات الصهيونية في فلسطين. لكن إلى جانب ذلك، نحن الآن أمام وقائع أخرى شديدة الحساسية يجب أن لا تغيب عن خطابنا السياسي والتعبوي، وبهذا نكون قد حافظنا على اتجاه البوصلة الصحيح في صراعنا الوجودي مع المخططات الصهيونية.
خلف دخان الدمار المُمنهج الذي تتعرض له فلسطين، خصوصاً قطاع غزة، نستطيع تلمس ثلاث مسائل أعتقد بأنها على قدر كبير من الأهمية، أو أنها في الطريق لكي تصبح ذات أهمية قريباً جداً:
المسألة الأولى ـ صحيح أن بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية مباشرة عن جرائم الحرب المُرتكبة في فلسطين. غير أن هذا لا يعني أن قيادات "إسرائيلية" أخرى قد تكون أقل عنفاً ووحشية! إن تجربتنا التاريخية مع الصهيونية، قبل قيام دولة الاغتصاب وبعده، تُظهر أن العنف والإرهاب والتهجير والإبادة هي صفات عامة "تمتع" بها كل الذين تولوا السلطة من بن غوريون إلى نتنياهو، مروراً بغولدا مائير ومناحيم بيغن وآرييل شارون... فالممارسات الإرهابية الدموية لا تنفصل عن البنية الاستراتيجية للقوات الصهيونية. ولمواجهة هذه المسألة، من الضروري تحريك دعاوى قضائية من خلال القانون الدولي ضد كل مجرمي الحرب. إذ حتى لو لم ننجح بسبب التدخلات السياسية، فإن مجرد إبقاء سيف العدالة مسلطاً فوق رؤوسهم يعتبر إنجازاً مفيداً.
المسألة الثانية ـ إن الرأي العام العالمي، أو غالبيته العظمى، يدين الارتكابات الصهيونية، ويتعاطف بصدق مع الفلسطينيين. كما وأن هناك بعض الشخصيات السياسية والفكرية، من دول معروفة بتأييدها المطلق لـ"إسرائيل"، يملكون من الشجاعة ما يجعلهم ينتقدون علناً وبشدة "السياسات الإسرائيلية". وهذا أمر مفيد على المستوى المعنوي، وله تأثيرات عميقة في حال ترافق مع الالتزام بحملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية. ومن الممكن التنسيق مع هذا الحراك العالمي، ووضع خطط مشتركة هدفها كشف الحقيقة العنصرية للدولة العبرية... وصولاً إلى نزع الشرعية القانونية والمعنوية عن "دولة إسرائيل".
لكن علينا أن لا نتوقع المعجزات من الرأي العام في الغرب الأميركي ـ الأوروبي، بل العمل الدؤوب على برامج محددة تتراكم تدريجياً لتصل إلى الغاية الأعلى. فإذا استثنينا الحراك الشعبي العالمي الذي عرّى الحرب الأميركية في فييتنام، وكذلك الحملات الدولية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فأنا لا أذكر حالات أخرى تمكن الرأي العام فيها من تغيير سياسات الدول، خصوصاً ما يتعلق بالدولة العبرية. بل يمكنني القول إن الرأي العام لوحده ما كان ليوقف حرب فييتنام لولا أن ثوار "الفيتكونغ" أعادوا إلى الأراضي الأميركية عشرات الألوف من جثث الجنود الأميركيين القتلى.
المسألة الثالثة، وهي مرتبطة بما ذكرناه في الفقرة السابقة ـ إن أوروبا (الاتحاد الأوروبي، الحلف الأطلسي، بريطانيا) باتت متماهية مع الموقف الأميركي الداعم لـ"إسرائيل" بمطلق الأحوال. كانت أوروبا، لسنوات خلت، تحاول أن تظهر بصفة الاعتدال بين "أطراف النزاع في الشرق الأوسط". وحرصت دائماً على إبقاء مسافة ملحوظة تميّزها عن انحياز واشنطن الأعمى لكل ما يرتكبه الصهاينة. وقد طرح مسؤولون أوروبيون في مراحل متعددة صيغاً مختلفة للتعاون مع العالم العربي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى انخراط "إسرائيل" لاحقاً في سوق شرق أوسطية واسعة وشاملة. ولكن لم يحدث قط أن أقدم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد الدولة الصهيونية رداً على خرقها للقوانين الدولية، ورفضها كل قرارات مجلس الأمن الدولي، وممارستها التمييز العنصري بحق الفلسطينيين. (كان قرار الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول بمعاقبة إسرائيل بعد حرب حزيران سنة 1967 الاستثناء الوحيد حتى الآن، على حد علمنا).
وعلى الرغم من التلكؤ الأوروبي في محاسبة "إسرائيل" رداً على ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، إلا أن الاتحاد الأوروبي من حيث أنه مؤسسة جامعة للدول الأعضاء، كان ـ على الأقل ـ يصدر بيانات تنديد ومناشدة وإدانة، تبقى كلها مجرد كلام بكلام، ووثيقة لا تأثير لها تنضم إلى مئات الوثائق التي تزدحم بها أدراج الاتحاد في بروكسل. وكانت تلك المواقف الكلامية تخدّر دول العالم العربي، فينام مسؤولوها على حرير الوعود المتكررة.
إن إحدى النتائج المذهلة للإرتكابات الصهيونية الحالية في فلسطين (وبالتحديد في قطاع غزة المحاصر)، تكشف لنا أن أوروبا تخلت حتى عن بيانات التنديد التي لا تقدم ولا تؤخر، وباتت في سرير واحد مع واشنطن وفي خندق واحد مع "إسرائيل". وهذا الموقف يتوّج خططاً نُفذت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت أوروبا تتبنى شيئاً فشيئاً وجهة النظر الصهيونية. فقد تم سن مجموعة من التشريعات القانونية، ظاهرها الحد من نزعة "معاداة السامية"، أما باطنها فهو حماية "إسرئيل" وقادتها من النقد والمحاسبة. واستهدفت القوانين الجديدة أيضاً الحملات الشعبية الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبارها أحد مظاهر "معاداة السامية". ومن ناحية موازية، تقرر تصنيف القوى الرافضة للمشروع الصهيوني على أنها "منظمات إرهابية"!
كل ذلك كان يجري علناً، لكن من دون ضجيج صاخب. ولعل "هيصة التطبيع" مع الدولة العبرية غطت نسبياً على المضامين الخطيرة لتلك التشريعات... إلى أن جاء العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين ليضع توجهات الغرب الأميركي ـ الأوروبي تحت المجهر. لقد تعرّت الحكومات حتى من ورقة التين الأخيرة. إن دولاً تفتخر تاريخياً بأنها ملتزمة بـ"الحياد"، مثل النمسا، لم تجد حرجاً في رفع الأعلام الإسرائيلية على بعض مبانيها الحكومية في خطوة "تضامنية" مع إسرائيل!! في حين واصلت دول أخرى شحن السلاح إلى الدولة الصهيونية، وقتما كانت القاذفات الأميركية الصنع تلقي صواريخها الأوروبية الصنع لتحصد المدنيين الأبرياء في القطاع المنكوب.
غداً سيتوقف العدوان الصهيوني بصيغة أو بأخرى، وسيعيد شعبنا الصابر في فلسطين بناء ما تهدم. إن الثمن الباهظ الذي دفعناه، وسندفعه، يفرض علينا واجب عدم إضاعته هباء. فالعدوان المستمر يكشف لنا عن عالم يتغيّر قومياً وإقليمياً وعالمياً. لذلك فإن استيعاب هذا التبدل، وبناء سياسات مضادة له، هما الشرط الأول للانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة الانتصار.
التاريخ: 2021-05-20
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro










