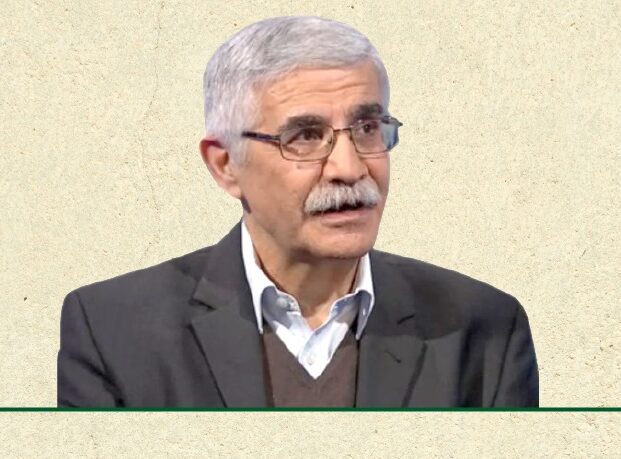
"إننا نعمل لأجيال لم تولد بعد"
فصل من كتاب "منارات من الأزمنة الجميلة"
كنا ننتظر قدوم إجازة فصل الصيف بفارغ الصبر. نشاطاتنا الحزبية المعتادة في إطار منفذية الطلبة الثانويين ومنفذية الطلبة الجامعيين تتوقف – عملياً – مع بدء موسم الإمتحانات المدرسية أو الرسمية. غير أننا كنا نتطلع دائماً إلى برامجنا الصيفية التي تتضمن، إجمالاً، مخيمات تدريبية مكثفة أو فعاليات إنمائية واجتماعية تجعلنا على تماس مباشر وحيوي مع قواعدنا الشعبية، خصوصاً في المناطق المتعاطفة تاريخياً مع الحزب السوري القومي الاجتماعي.
في صيف العام 1971، وكان قد مضى على انتمائي الحزبي أكثر من سنتين، أبلغني المنفذ العام لمنفذية الطلبة الثانويين الرفيق توفيق ميلان أن موسمنا لهذا العام سيكون العمل الشعبي الإنمائي في الأرياف. وبما أنني، في الأصل، من بلدة الهرمل البقاعية، فقد تقرر أن أنضم إلى مجموعة الرفقاء الطلبة الثانويين الذاهبين إلى بلدة النبي عثمان للمشاركة مع رفقائنا هناك في عدد من المشاريع الملحة في البلدة التي تفتخر بأن "الديوك عندما تصيح فيها صباحاً... تهتف: تحيا سوريا".
سُررتُ بهذا الترتيب. أولاً، لأني أفضل العمل الإنمائي الاجتماعي في الأوساط الشعبية على الثرثرات والمماحكات السياسية في أزقة المدن ومقاهيها. وثانياً، لأني أعرف النبي عثمان وأهلها معرفة وثيقة تعود إلى زمن اعتاد أهلي فيه على قضاء فصل الصيف هناك، خصوصاً بعد أن تزوجت عمتي فاطمة من المواطن علي مهدي نزهة واستقرت معه في البلدة وأنجبت عائلة قومية اجتماعية. وكان من الطبيعي أن أنزل في بيت عمتي – كما هي عادتي الصيفية – عندما أزور النبي عثمان وأسرح في بساتينها المثمرة التي ترويها قناة غزيرة المياه تمتد من نبع اللبوة المجاور وتواصل جريانها إلى بلدة العين وما بعدها شمالاً.
توجهنا إلى النبي عثمان بصورة متفرقة، كل واحد منا بطريقته الخاصة. واستقبلنا الرفقاء هناك بكل المودة والمحبة والإلفة المعروفة عنهم. وتوزعنا في بيوت القوميين الاجتماعيين المنتشرة في الضيعة الجبلية قرب البيادر، وكذلك في السهل حيث لم تكن تكاثرت بعد منازل الإسمنت والباطون المسلح، بل كل ما هنالك مصاطب صيفية تظللها الأشجار وتحيط بها الخضرة والمياه من كل صوب. ثم إلتقينا جميعاً في بيت المنفذ العام الأمين ديب كردية للتعارف وتوزيع المهمات المطلوب تنفيذها خلال الأيام العشرة التي سنقضيها في النبي عثمان.
أخبرنا المسؤولون الحزبيون المحليون أن الحاجة ملحة لتنظيف قناة المياه الأساسية الآتية من نبع اللبوة، فمع أنها مبنية من الباطون إلا أن عوامل الزمن والإهمال أدت إلى تراكم الحجارة والأتربة في بعض أجزائها. غير أن أسوأ ما في الأمر أن النباتات البرية وشجيرات العليق الشوكي باتت تغطي معظم أقسامها بحيث أصبحت تشكل خطراً على الصحة العامة... هذا إذا عرفنا أنها المصدر الوحيد لمياه الشرب في منطقة السهل كلها، ولذلك بات من الضروري إزالة الركام كي تصبح حافتا القناة مكشوفتين ونظيفتين تماماً.
تقرر أن يتولى العدد الأكبر من الرفقاء تنظيف القناة وتعزيلها، في حين يتعهد الباقون إجراء إصلاحات وصيانة على الطريق الزراعي الممتد بمحاذاة القناة والذي تعرض في بعض أجزائه لانهيارات أرضية جعلت من الصعب مرور السيارات والشاحنات الصغيرة عليه إلا بمشقة بالغة. وهذه أيضاً مسألة حيوية للأهالي لأن تصريف الإنتاج الزراعي للبلدة، من تفاح وخوخ ومشمش وكرز ودراق وخضار موسمية متنوعة، يجد منفذه الوحيد عبر هذا الطريق... الوحيد أيضاً!
المهم أنني كنت مع مجموعة ورشة القناة، أو الساقية كما يعرفها أبناء النبي عثمان. تسلحنا بالمعاول والمجارف والشِوَك وانطلقنا من آخر سهول النبي عثمان بالقرب من بلدة العين نزولاً باتجاه نبع اللبوة، على أمل أن ننجز عملنا عند الظهيرة فنلتقي هناك رفقاء ورشة الطريق لتناول طعام الغداء في المرجة الواسعة المطلة على النبع، وحيث يكون رفقاء ورفيقات أعدوا الطعام من "حواضر البيت" كما يقولون.
المجموعة التي عملتُ معها كانت مؤلفة من الرفيق حسين علي إبراهيم نزهة (أستشهد في معركة الدفاع عن مركز الحزب في منطقة جل الديب) والرفيق عاشق العاشق الذي أصبح صهري لاحقاً والرفيق محمد علي مهدي نزهة، ومعنا المنفذ العام الرفيق توفيق ميلان. رفيقان يتوليان قطع النباتات البرية وتشحيل شجيرات العليق عن طرفي الساقية، ورفيق ينتظر على مسافة أبعد عند أسفل مجرى المياه ومعه شوكة تعترض الماء وتلتقط النباتات المقصوصة الطافية مع السيل، ورفيق آخر يجمع هذه النباتات ويضعها على جانب الطريق، ثم ينظف قعر الساقية من الحصى والأتربة بعد أن نكون قد تقدمنا مسافة إلى الأمام.
كنا في خضم انشغالنا عندما وصل الأمين ديب كردية لتفقد أحوال الرفقاء، ووقف في الوسط بين الرفيقين اللذين كانا يقطعان النباتات وبيني أنا الذي أحمل الشوكة وأعترض مجرى المياه. وكان يحدث أن تتراكم هذه النباتات بحيث تعرقل السيل فيحدث احتقان وتفيض المياه حتى تتجاوز حافتي القناة، إلى أن أرفع الأغصان العالقة فتعود الساقية إلى مسراها الطبيعي السريع. وبينما الأمين ديب في حديث مع الرفيق توفيق، إذ بقدمه تزل من جراء إنزلاق بعض الحصى... ليقع في الساقية على ظهره! وكانت المياه في تلك اللحظة طافحة، والأمين ديب بقامته الممتلئة ساهم في زيادة الطفح حتى طافت المياه على الجانبين... فصرخت بأعلى صوتي، وقد كنت على مبعدة أمتار منه: "يا رفقاء، راح المنفذ العام في الساقية"!
وما كاد الرفيقان العاملان في الأمام يصلان إليه إلا وكان الأمين ديب قد هبّ من وقعته، وصعد إلى الحافة اليسرى من الطريق العام وهو مبلل من رأسه حتى أخمص قدميه، والتفت نحوي ضاحكاً وهو يتوعدني بيده التي تقطر ماءً: "راح المنفذ العام في الساقية؟ ولو يا رفيق أحمد، المنفذ العام الذي لم تغلبه الملاحقات والسجون والمعارك لن يذهب ضحية ساقية بالكاد تصل مياهها إلى ركبتيه". وشاركناه جميعاً في الضحك، وأنا أشعر بحرج داخلي مكبوت... وانتهى ذلك اليوم بحفلة غداء احتضنت كل الرفقاء قرب نبع اللبوة لا أروع ولا أجمل.
سهرة المساء في ذلك اليوم كانت في بيت الأمين ديب قرب البيادر. صمتُ الليل الريفي يُخيم على البيوت الطينية المتناثرة قرب الجامع بعد أن أوى معظم الناس إلى منازلهم الصيفية المؤقتة في السهل. إجتمعنا حوالي الأربعين رفيقاً ومواطناً من الطلبة الثانويين والجامعيين وأبناء النبي عثمان والعين. أحاديث اجتماعية وحزبية متنوعة محورها الأمين ديب الذي سرد لنا بعض وقائع وخبايا المحاولة الإنقلابية والاعتقالات والتعذيب والسجن في الستينات. وبين حين وآخر كانت طرفة "راح المنفذ في الساقية" تطفو على سطح الكلام فيضحك الحضور، ويلتفت الأمين ديب نحوي معاتباً بمودة وإلفة.
ولا بد هنا من فتح مزدوجين اعتراضيين لإيضاح مسألة تتعلق بكنيتنا العائلية حتى نستوعب لاحقاً ما سأرويه عن خاتمة تلك السهرة. نحن من الهرمل أصلاً، ونُعرف هناك بإسم "بيت العجمي" نظراً إلى أن جدي لأبي هاجر في زمن مضى من إيران إلى لبنان فأطلقوا عليه لقب "العجمي". غير أن كنيتنا الرسمية في السجلات الحكومية كانت "أصفهاني"، وأنا كنت "أحمد أصفهاني" في سجلات المدرسة وإضبارات الحزب... وقد عرفني الأمين ديب بهذا الإسم.
نعود إلى السهرة التي امتدت حتى ما بعد منتصف الليل، وقد حان وقت أن نتوزع على بيوت الرفقاء للنوم. كان الأمين ديب يشرف على هذه الترتيبات ليتأكد من أن كل رفيق من خارج الضيعة ذهب مع رفيق أو مواطن من النبي عثمان لقضاء الليل عنده. وعندما حان دوري، سألني الأمين ديب عن المكان الذي سأبيت فيه ليلتي، فأجبته ببساطة: "أنا نازل عند بيت عمتي في السهل". استغرب إجابتي، وتابع متسائلاً: "عمتك في السهل؟ من هي عمتك؟" أجبته بلهجة الأمر المفروغ منه: "عمتي فاطمة، زوجة علي مهدي نزهة". إنتفض الأمين ديب في مكانه، وسألني بصوت مرتبك ومتحمس: "فاطمة العجمية زوجة أبو مهدي هي عمتك؟" قلت بهدوء: "نعم"!
فجأة خيّم صمت ثقيل على الغرفة التي كانت قبل لحظات قليلة تضج بعشرات الأحاديث وتخفق بحركة الرفقاء وهم يستعدون للمغادرة. للحظة شعر الجميع وكأن سكون العتمة الحالكة في الخارج غشي على محيا الأمين ديب الذي اغرورقت عيناه بالدمع. وبعد ثوان حسبتها دهراً، سألني بصوت متهدج: "إذن أنت أحمد، إبن محمد الحاج رضا العجمي؟" كانت أحاسيس الاستغراب قد امتلكت كياني كله وعقدت أربطة لساني، فلم أستطع النطق بل اكتفيت بهز رأسي موافقاً... عندها انهمرت دموع الأمين ديب التي جاهد كثيراً لضبطها، لكن من دون جدوى.
أذهلتنا المفاجأة، فعدنا جميعاً لنجلس على الأرائك والحُصر المفروشة على الأرض الطينية الباردة، وعيوننا شاخصة إلى الأمين ديب ننتظر أن يهدأ نحيبه الصامت بينما صدره يرتفع وينخفض بقوة تعكس عمق المشاعر المختلجة في قلبه وعقله. دقائق مرت من دون أن يجرؤ أحدنا على خرق ذلك السكون الثقيل. وبين الحين والآخر كان الأمين ديب يختلس النظر إليّ ثم يحول عينيه إلى السقف المحمول على جذوع شجر الحور وهو عاجز عن وقف سيل الدموع المنهمرة.
أخيراً استجمع أنفاسه، وتوجه بالحديث إليّ قائلاً: "هل تعرف يا رفيق أحمد أن بين عائلتنا وعائلتكم علاقة تاريخية وثيقة؟" أجبته: "أعرف ذلك، وكثيراً ما حدثني أبي عن الأمين ديب المسجون بسبب المحاولة الإنقلابية".
نقل الأمين ديب حديثه من المستوى الشخصي إلى المستوى العام مخاطباً الحضور جميعاً: "في أواخر الخمسينات، كنت أزور بيت أبو أحمد في منطقة برج حمود النبعة لتفقد أحوال العائلة، خصوصاً بعدما أصيبت المرحومة زينب، أم الرفيق أحمد، بمرض الفالج الذي أقعدها في الفراش إلى حين وفاتها. وكنت ألاعب الأطفال صالحة وعليا وأحمد (الصغير علي كان في أشهره الأولى) بينما أبو أحمد يجهز إبريق الشاي الممتاز وأم أحمد ممددة في فراشها تشارك في الحديث، لكنها لا تقوى على الحركة. أحمد كان الطفل المدلل، وكنت أدعوه إليّ فيأتي نحوي ويجلس في حضني وأطلب منه أن يقول "تحيا سوريا"، لكنه كان يرفض بعناد. وكنت أكرر عليه الطلب بإلحاح من دون طائل، إلى أن أخرج من جيب سروالي قطعة معدنية من فئة الربع ليرة وأقول له: "إذا قلت تحيا سوريا سأعطيك هذه الربع". فكان يقف باستعداد ويؤدي التحية هاتفاً تحيا سوريا... ثم يخطف القطعة المعدنية من يدي ويهرب إلى أقرب دكان".
وتابع الأمين ديب كلامه بعد توقف قصير ليمسح ما تبقى من آثار الدموع على وجنتيه: "... وانقطعت الإتصالات بين عائلتينا بعد فشل الإنقلاب. نحن دخلنا السجن، وتوفيت أم أحمد، وانتقل بيت العجمي جميعاً من برج حمود إلى النبعة لبدء حياة جديدة من دون حنان الأم... وسرقَ الأسرُ سبع سنوات كاملة من أعمارنا. وفجأة أشاهد أمامي الطفل "الأزعر" أحمد وقد أصبح شاباً ورفيقاً "أزعر"! وبلحظة أدركت أن العمر يهرب منا بسرعة، وأن عالماً كاملاً فقدناه ونحن في غياهب السجن. صدمتني هذه المفاجأة، فبكيت. غير أني أدرك الآن بصورة جلية ما قصده حضرة الزعيم عندما أكد لنا أننا نعمل لأجيال لم تولد بعد".
ثم التفت الأمين ديب نحوي قائلاً ببسمة هادئة تحمل عمق المحبة التي يكنها لنا ولجميع رفقائه: "كنتَ ترفض أن تقول "تحيا سوريا" إذا لم أدفع لك ربع ليرة، أما اليوم فها إنك تهتف "تحيا سوريا" وأنت تدفع جهدك وعرقك ودمك من أجل النهضة".
وما أن أكمل عبارته هذه حتى هبّ على الفور واقفاً باستعداد عسكري هاتفاً: "تحيا سوريا رفيق أحمد، تحيا سوريا حضرات الرفقاء... وتصبحون على خير". نهضنا جميعاً وكأننا نلبي إيعازاً حزبياً غير منظور، هاتفين: "تحيا سوريا حضرة الأمين... تحيا سوريا".
التاريخ: 2022-03-05
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro









